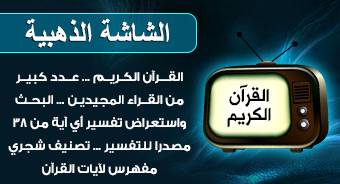.تفسير الآية رقم (42):
.تفسير الآية رقم (42):
القول في تأويل قوله تعالى:
{إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} [42].
{إِذْ أَنتُم} بدل من يوم الفرقان، أو ظرف لمحذوف، أي: اذكروا إذ أنتم يا معشر المؤمنين
{بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا} يعين بشفير الوادي الأدنى من المدينة،
{وَهُم} يعني المشركين أبا جهل وأصحابه
{بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى} أي: البُعدَى عن المدينة، مما يلي مكة
{وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ} أي: العير التي فيها أبو سفيان، بما معه من التجارة التي كان الخروج لأجلها، أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر.لطيفة:قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت، وذكر مراكز الفريقين، وأن العير كانت أسفل منهم؟قلت: الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدوّ وشوكته وتكامل عدته، تمهّد أسباب الغلبة له، وضعف شأن المسلمين، والتباث أمرهم، وأن غلبتهم في مثل هذا الحال، ليست إلا صنعاً من الله سبحانه، ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته، باهر قدرته، وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون، كان فيها الماء، كانت أرضاً لا بأس بها، ولا ماء بالعدوة الدنيا، وهي خبار- ما لان من الأرض واسترخى- تسوخ فيه الأرجل، ولا يمشي فيها إلا بتعب ومشقة، وكانت العير وراء ظهور العدو، مع كثرة عددهم، فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم، وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم، ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم، ليبعثهم الذبّ عن الحريم، والغيرة على الحرب، على بذل جُهيداهم في القتال، وألا يتركوا وراءهم ما يحدّثون أنفسهم بالإنحياز إليه، فيجمع ذلك قلوبهم، ويضبط همومهم، ويوطن نفوسهم، على ألا يبرحوا موطنهم، ولا يُخلوا مراكزهم، ويبذلوا منتهى نجدتهم، وقصارى شدتهم، وفيه تصوير ما دبّر سبحانه من أمر وقعة بدر، ليقضي أمراً كان مفعولاً، من إعزاز دينه، وإعلاء كلمته، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين، مبهمة غير مبينّة، حتى خرجوا ليأخذوا العير، راغبين في الخروج، وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم، حتى نفروا ليمنعوا غيرهم، وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا، وهؤلاء بالعدوة القصوى، ووراءهم العير يحامون عليها، حتى قامت الحرب على ساق، وكان ما كان، انتهى.قال الناصر في الإنتصاف: وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري، وتنقيبه عن أسرار الكتاب العزيز.وقوله تعالى:
{وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ} أي: ولو تواعدتم أنتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال، لخالف بعضكم بعضاً، فثبطكم قلتكم وكثرتهم، على الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من تهيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسبب له. قاله الزمخشري.وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.وروى ابن جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر، ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، حتى التقى السقاة وشهد الناس بعضهم إلى بعض.
{وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} أي: ولكن جمع بينكم على هذه الحال على غير ميعاد، ليقضي ما أراد من إعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وأهله، من غير ملأ منكم.وقوله:
{كاَنَ مَفْعُولاً} أي: حقيقاً بأن يفعل، وقيل:
{كان} بمعنى صار، أي: صار مفعولاً، بعد أن لم يكن، وقيل: إنه عبر به عنه لتحققه حتى كأنه مضى.وقوله تعالى:
{لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ} أي: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد، لينصركم عليهم، ويرفع حجة الحق على الباطل، ليصير الأمر ظاهراً، والحجة قاطعة، والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، أي: يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره، أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويؤمن من آمن عن حدة وبصيرة ويقين، بأنه دين الحق، الذي يجب الدخول فيه، والتمسك به.وذلك أن ما كان من وقعة بدر، من الآيات الغرّ المحجّلة، التي من كفر بعدها، كان مكابراً لنفسه، مغالطاً لها.لطائف:الأولى: قوله تعالى:
{لِيَهْلِكَ} بدل من:
{لِيَقْضِيَ} أو متعلق بـ:
{مفَعْولاً}.الثانية: الحياة والهلاك استعارة للكفر والإسلام، وقرئ:
{ليهلَك} بفتح اللام.الثالثة:
{حَيَّ} يقرأ بتشديد الياء، وهو الأصل، لأن الحرفين متماثلان متحركان، فهو مثل شدّ ومدّ، ومنه قول عبيدة بن الأبرص:
عَيُّوا بأمرهِمُ كما ** عيَّتْ بِبْيضتها الحمامَهْويقرأ بالإظهار وفيه وجهان:أحدهما: أن الماضي حمل على المستقبل، وهو يحيا، فكما لم يدغم في المستقبل، لم يدغم في الماضي، وليس كذلك شد ومد، فإنه يدغم فيهما جميعاً.والوجه الثاني: أن حركة الحرفين مختلفة، فالأولى مكسورة، والثانية مفتوحة، واختلاف الحركتين، كاختلاف الحرفين، ولذلك أجازوا في الاختيار: لححت عليه، وضبب البلد، إذا كثر ضبه، ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة، فكأن الياء الثانية: ساكنة، ولو سكنت لم يلزم الإدغام، وكذلك إذا كانت في تقدير الساكن، والياآن أصل، وليست الثانية بدلاً من واو، فأما الحيوان، فالواو فيه بدل من الياء. وأما الحواء، فليس من لفظ الحية، بل من حوى يحوي إذا جمع- قاله أبو البقاء-.
{وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} أي: بكفر من كفر وعقابه، وإيمان من آمن وثوابه.وقوله تعالى:
 .تفسير الآية رقم (43):
.تفسير الآية رقم (43):
القول في تأويل قوله تعالى:
{إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [43].
{إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً} منصوب بأذكر، أو بدل آخر من يوم الفرقان، وذلك أن الله عز وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاً، فأخبر بذلك أصحابه، فكان تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوهم:
{وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ} أي: لجبنتم وهبتم الإقدام.
{وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ} أي: أمر الإقدام والإحجام، فتفرقت كلمتكم،
{وَلَكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ} أي: عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته
{إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} أي: يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع. ولذلك دبر ما دبر.
 .تفسير الآية رقم (44):
.تفسير الآية رقم (44):
القول في تأويل قوله تعالى:
{وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} [44].
{وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً} وذلك تصديقاً لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعاينوا ما أخبرهم به، فيزداد يقينهم، ويجدوا، ويثبتوا.قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيينا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة! فأسرنا رجلاً منهم، فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفاً!- رواه ابن أبي حاتم وابن جرير-.
{وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ} أي: في اليقظة، حتى قال أبو جهل: إن محمداً وأصحابه أكلة جزورٍ، مثل في القلة، كأكلة رأس، أي: أنهم لقلتهم يكفيهم ذلك.وأكلة بوزن كتبة، جمع آكل، بوزن فاعل، والجزور الناقة، كذا في العناية.
{لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً} أي: من إظهار الخوارق الدالة على صدق دين الإسلام، وكذب دين الكفر.
{كَانَ مَفْعُولاً} أي: كالواجب فعله على الحكيم، لما فيه من الخير الكثير. قاله المهايمي.لطائف:الأولى: قال الزمخشري: فإن قلت: الغرض في تقليل الكفار في أَعْيَن المؤمنين ظاهر، فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟قلت: قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء، ثم كثرهم فيها بعده، ليجترئوا عليهم، قلة مبالاة بهم، ثم تفجؤهم الكثرة، فيبهتوا ويهابوا، وتفلَّ شوكتهم، حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم، وذلك قوله:
{يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ} ولئلا يستعدوا لهم، وليعظم الإحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولاً وكثرتهم آخراً.الثانية: قال الزمخشري أيضاً: فإن قلت: بأي طريق يبصرون الكثير قليلاً؟قلت: بأن يستر الله عنهم بعضه بساتر، أو يحدث في عيونهم ما يستلون به الكثير، كما أحدث في أَعْيَن الحول ما يرون به الواحد اثنين قيل لبعضهم: إن الأحول يرى الواحد اثنين- وكان بين يديه ديك واحد- فقال: مالي لا أرى هذين الديكين أربعة؟ انتهى.قال الناصر في الإنتصاف: وفي هذا- يعني كلام الزمخشري- دليل بين على أن الله تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة، أو قرب، أو ارتفاع حجب، أو غير ذلك، إذا لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً، لما أمكن أن يستر عنهم البعض، وقد أدركوا البعض، والسبب الموجب مشترك.فعلى هذا يجوز أن يخلق الله الإدراك مع اجتماعها، فلا ربط إذن بين الروية ونفيها في مقدرة الله تعالى؟ وهي رادّة على القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى، بناءاً على اعتبار هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلاً، وأنها تستلزم الجسمية، إذ المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسم.فهذه الآية حسبهم في إبطال زعمهم، ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون. والله الموفق.الثالثة: لا يقال: إن قوله تعالى:
{لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} مكرر مع ما سبق. لأنا نقول: إن المقصود من ذكره أولاً هو اجتماعهم بلا ميعاد ليحصل استيلاء المؤمنين على المشركين، على وجه يكون معجزة دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه هاهنا بيان خارق آخر، وهو تقليلهم في أَعْيَن المشركين، ثم تكثيرهم للحكمة المتقدمة.وفي قوله تعالى:
{وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُمُورُ} تنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتها، وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زاداً ليوم المعاد.ثم أرشد تعالى عباده المؤمنين إلى آداب اللقاء في ميدان الوغى، ومبارزة الأعداء، بقوله سبحانه:
 .تفسير الآية رقم (45):
.تفسير الآية رقم (45):
القول في تأويل قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} [45].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ} أي: إذا حاربتم جماعة فاثبتوا للقائهم واصبروا على مبارزتهم، فلا تفروا ولا تجبنوا ولا تنكلوا، وتفسير اللقاء بالحرب لغلبته عليه، كالنزال ولم يصف الفئة بأنها كافرة، لأنه معلوم غير محتاج إليه.
{وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً} أي: في مواطن الحرب، مستظهرين بذكره مستنصرين به، داعين له على عدوكم
{لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} أي: تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة.وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال:
«يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف».ثم قال:
«اللهم منزل الكتاب، ومُجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم».وفي الآية إشعار بأن على العبد ألا يفتُر عن ذكر ربه، أشغل ما يكون قلباً، وأكثر ما يكون هماً، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد، ويقبل إليه بكليته، فارغ البال، واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال...
 .تفسير الآية رقم (46):
.تفسير الآية رقم (46):
القول في تأويل قوله تعالى:
{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [46].
{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ} أي: في كل ما يأمران به وينهيان، وهذا عامّ والتخصيص بالذكر هنا فيه تأكيد:
{وَلاَ تَنَازَعُواْ} أي: باختلاف الآراء، أو فيما أمرتم به
{فَتَفْشَلُواْ} أي: تجبنوا، إذ لا يتقوى بعضكم ببعض.
{وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} أي: قوتكم وغلبتكم، ونصرتك ودولتكم، شبه ما ذكر في نفوذ الأمر وتمشيته، بالريح وهبوبها، ويقال: هبت رياح فلان، إذا دالت له الدولة ونفذ أمره، قال:
إذا هبّت رياحك فاغتنمها ** فإن لكل خافقةٍ سكُونُولا تغفَلْ عن الإحسانِ فيها ** فما تَدرِي السكونَ متى يكونُ{وَاصْبِرُواْ} أي: على شدائد الحرب، وعلى مخالفة أهويتكم الداعية إلى التنازع، فالصبر مستلزم للنصر
{إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} أي: بالنصر.قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم، وفي باب الشجاعة والإئتمار بما أمرهم الله ورسوله، وامتثال ما أرشدهم إليه، ما لم يكن لأحد من الأمم، والقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم، فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً، وفي المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم، من الروم والفرس والترك، والصقالبة والبربر والحبوش، وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، في أقل من ثلاثين سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجميعن.تنبيه:قال بعض المفسرين في قوله تعالى:
{وَلاَ تَنَازَعُوا}، أي: لا تختلفوا فيما أمركم به من الجهاد، بل ليتفق رأيكم.قال: ولقائل أن يقول: استثمر من هذا وجوب نصب أمير على الجيش ليدبّر أمرهم. ويقطع اختلافهم، فإن بلزوم طاعته، ينقطع الإختلاف، وقد فعله صلى الله عليه وسلم في السرايا، وقال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي. انتهى.ولما أمر تعالى المؤمنين بالثبات والصبر عند اللقاء، أمرهم بالإخلاص فيه، بنهيهم عن التشبه بالمشركين، في انبعاثهم للرياء، بقوله سبحانه: