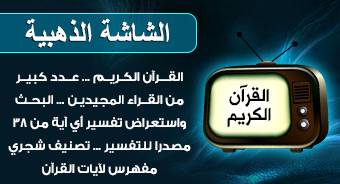|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد **
ثبت في (الصحيحين): من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما، أنه سمع النبىَّ صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللَّهَ ورسولَه حرَّم بيع الخمر، والميتةِ، والخِنزير، والأصْنَام). فقيل: يا رَسُول اللَّه: أرأيت شُحوم الميتة، فإنها يُطلى بها السُّفن، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ؟ فقال: (لاَ، هُوَ حَرَامٌ) ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم عند ذلك : (قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِم شُحُومَها جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأَكلوا ثَمَنَهُ). وفيها أيضاً: عن ابن عباسٍ، قال: بَلغَ عُمَرَ رضى اللَّه عنه أنَّ سًمُرَةَ باع خمراً فقال: قاتلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، ألم يعلمْ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا). فهذا من مسند عمر رضى اللَّه عنه، وقد رواه البيهقىُّ، والحاكم في (مستدركه)، فجعلاه من (مسند ابن عباس)، وفيه زيادة، ولفظه: عن ابن عباس، قال: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعنى الحرامَ، فرفع بصرَهُ إلى السماءِ، فتبسَّم فقال : (لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْهمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمانها، إنَّ اللَّهُ إذَا حَرَّمَ عَلى قَوْمٍ أَكْلَ شَىءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ). وإسناده صحيح، فإن البيهقى رواه عن ابن عبدان، عن الصفار، عن إسماعيل القاضى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد الحذَّاء، عن بركة أبى الوليد، عن ابن عباس. وفى (الصحيحين) من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه. نحوه، دون قوله: (إن اللَّه إذا حَرَّم أَكْلَ شَىءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ). فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشاربَ تُفْسِدُ العقول ومطاعِمَ تُفْسِدُ الطِّبَاع وتغذِّى غِذاءً خبيثاً ؛ وأعيانٍ تُفْسِدُ الأديان، وتدعو إلى الفِتنةِ والشِّرْك. فصانَ بتحريم النوع الأول العقولَ عما يُزيلها ويُفْسِدُها، وبالثانى: القلوبَ عما يُفْسِدها من وُصُولِ أثرِ الغذاءِ الخبيثِ إليها، والغاذى شبيهُ بالمغتذى، وبالثالث: الأديانَ عما وُضِعَ لإفسادها. فتضمن هذا التحريمُ صِيانةَ العقولِ والقلوبِ والأديان ولكن الشَّأنَ في معرفة حدود كلامه صلوات اللَّه عليه، وما يدخل فيه، وما لا يدخل فيه، لِتستبين عمومُ كلماته وجَمْعِهَا، وتناوُلِها لجميع الأنواع التي شَمِلَها عمومُ كلماتِهِ، وتأويلها بجميع الأنواع التي شَمِلَها عمومُ لفظه ومعناه، وهذه خاصِيَّةُ الفهم عن اللَّهِ ورسولِه التي تفاوت فيه العلماءُ ويُؤتيه اللَّه من يشاء. فأمَّا تحريمُ بيعِ الخمرِ، فيدخل فيه تحريمُ بيعِ كلِّ مسكر، مائعاً كان، أو جامداً عصيراً، أو مطبوخاً، فيدخل فيه عَصيرُ العِنَبِ، وخَمرُ الزبيبِ، والتمر، والذُّرَةِ، والشَّعِيرِ، والعَسَل والحِنْطَةِ، واللقمةِ الملعونة، لقمة الفسق والقلب التي تُحرِّك القلبَ الساكنَ إلى أَخبثِ الأماكن، فإن هذا كُلَّه خَمْرٌ بنص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصحيح الصَريح الذي لا مَطْعَنَ في سنده، ولا إجمالَ في متنه، إذ صح عنه قوله: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر). وصح عن أصحابه رضى اللَّه عنهم الذين هم أعلمُ الأُمَّةِ بخطابه ومُراده: أنَّ الخَمْرَ مَا خَامَرَ العَقْلَ فدخولُ هذه الأنواع تحت اسم الخمر، كدخول جميع أنواع الذهب والفضَّةِ، والبُرِّ والشعيرِ، والتمرِ والزبيب، تحت قوله: (لا تبيعوا الذهبَ بالذهب، والفِضةَ بالفضة، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتمرِ، والملحَ بالملحِ إلا مِثْلاً بمثل). فكما لا يجوز إخراجُ صِنْف من هذه الأصناف عن تناوُل اسمه له، فهكَذا لا يجوزُ إخراجُ صِنف من أَصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمَّن محذورين. أحدهما: أن يُخْرجَ مِن كلامه ما قصَدَ دخولَه فيه. والثانى: أن يُشرع لذلك النوعِ الذي أخرج حكمٌ غير حكمه، فيكون تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنه إذا سمَّى ذلك النوعَ بغير الاسم الذي سَمَّاه به الشارع، أزال عنه حكم ذلك المسمَّى، وأعطاه حكماً آخر. ولما علم النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن مِنْ أُمَتِهِ مِنْ يُبْتَلى بهذا، كما قال: (ليَشْرَبنَّ ناسٌ مِنْ أُمَّتى الخَمْرَ يُسَمُّونَها بِغَيْرِ اسْمِها). قضى قضية كليةً عامةً لا يتطرَّق إليها إجمال، وَلاَ احتمال، بل هي شافيةٌ كافيةُ، فقال: (كُلُّ مُسْكِر خَمْر)، هذا ولو أن أبا عُبَيدة، والخليلَ وأضرابَهما مِن أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا، لقالوا: قد نصَّ أئمةُ اللغة على أنَّ كُلَّ مسكرٍ خمر، وقولُهم حجة، وسيأتى إن شاء اللَّه تعالى عندَ ذِكْرِ هَدْيهِ في الأطعمة والأشربة مزيدُ تقرير لهذا، وأنه لو لم يتناوله لفظُه، لكان القياسُ الصريح الذي استوى فيه الأصلُ والفرعُ مِن كل وجه حاكماً بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشُّرْب، فالتفريقُ بينَ نوع ونوع، تفريقٌ بين متماثلين من جميع الوجوه. وأما تحريمُ بيع الميتة، فيدخل فيه كُلُّ ما يسمَّى ميتةً، سواء مات حتف أنفه، أو ذُكِّىَ ذكَاةً لا تُفيد حِلَّه. ويدخل فيه أبعاضُها أيضاً. ولهذا استشكل الصحابةُ رضى اللَّه عنهم تحريمَ بيع الشحم، مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبرهم النبىُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه حرامٌ وإن كان فيه ما ذكروا مِن المنفعة وهذا موضعٌ اختلف الناسُ فيه لاختلافهم في فهم مرادِه صلى الله عليه وسلم، وهو أنَّ قوله: (لا، هوَ حرام): هل هو عائد إلى البيع، أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيخُنا: هو راجع إلى البيع، فإنه صلى الله عليه وسلم لَمَّا أخبرهم أنَّ حَرَّم بيع الميتة، قالوا: إن في شحومها مِن المنافع كذا وكذا، يعنون، فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: (لا، هو حَرَام). قلت: كأنهم طلبوا تخصيصَ الشحوم من جملة الميتة بالجواز، كما طلب العباسُ رضى اللَّه عنه تخصيصَ الإذْخر من جملة تحريم نَبات الحَرَمِ بالجواز، فلم يجبهم إلى ذلك، فقال: (لا، هو حرام). وقال غيرُه من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريمُ عائد إلى الأفعال المَسؤول عنها، وقال: هو حرام، ولم يقل: هي، لأنه أراد المذكورَ جميعَه، ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور، ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعةٌ إلى اقتناء الشحوم وبيعها، ويُرجحه أيضاً: أن في بعض ألفاظ الحديث، فقال: (لا، هي حرام)، وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم، وإما إلى هذه الأفعال، وعلى التقديرين، فهو حُجَّةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. ويرجحه أيضاً قولُه في حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه في الفأرة التي وقعت في السمن: (إنْ كَانَ جَامِداً فَأَلقُوهَا ومَا حَوْلها وكُلُوهُ، وإنْ كَانَ مَائِعاً فَلا تَقْرَبُوهُ). وفى الانتفاع به في الاستصباح وغيره قُربان له. ومن رجَّح الأول يقول: ثَبَتَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُها)، وهذا صريحُ في أنه لا يحرم الانتفاعُ بها في غير الأكل، كالوقيدِ، وسَدِّ البُثوقِ، ونحوهما. قالوا: والخبيث إنما تحرُمُ ملابسته باطناً وظاهراً، كالأكل واللُّبْسِ، وأما الانتفاعُ به من غير مُلابسة، فَلأىِّ شىءٍ يحرم؟ قالوا: ومن تأمل سياقَ حديث جابر، علم أن السؤالَ إنما كان منهم عن البيع، وأنَّهم طلبوا منه أن يُرخِّص لهم في بيع الشحوم، لما فِيها من المنافع، فأبى عليهم وقال: (هو حرام)، فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال، لقالوا: أرأيتَ شحومَ الميتة، هل يجوز أن يَستصبحَ بها الناسُ، وتُدهَنَ بها الجلودُ ؛ ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذا، فإن هذا إخبار منهم، لا سؤال، وهم لم يُخبروه بذلك عقيبَ تحريم هذه الأفعال عليهم، ليكون قوله: (لا، هو حرام) صريحاً في تحريمها، وإنما أخبروه به عقيبَ تحريم بيع الميتة، فكأنهم طلبوا منه أن يرخِّص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها، فلم يفعل. ونهايةُ الأمر أن الحديثَ يحتمل الأمرين، فلا يحرم ما لم يعلمْ أنَّ اللَّه ورسوله حَرَّمه. قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء مِن آبار ثمود، وأباح لهم أن يُطْعِمُوا ما عجنُوا مِنه من تلك الآبار للبهائم، قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسةِ والاستصباحَ بها انتفاعٌ خالٍ عن هذه المفَسْدَةِ، وعن ملابستها باطناً وظاهراً، فهو نَفْعٌ مَحْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذا، فالشريعةُ لا تحرِّمه، فإن الشريعة إنما تحرِّم المفاسدَ الخالصةَ أو الراجحةَ، وطرقَها وأسبابهَا الموصلةَ إليها. قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباحَ بشحوم الميتة إذا خالطت دُهناً طاهراً، فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحُ بالزيت النجِس، وطلىُ السفن به، وهو اختيارُ طائفة من أصحاب، منهم: الشيخ أبو محمد، وغيره، واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبحَ به. وقال في رواية ابنيه: صالح وعبد اللَّه: لا يعجبنى بيع النَّجس، ويستصبحُ به إذا لم يمسوه، لأنه نجس، وهذا يعم النجِّسَ، والمتنجِّس، ولو قُدِّرَ أنه إنما أراد به المتنجِّس، فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرها، وهذا مذهبُ الشافعى، وأىُّ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفرداً، وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ فإن قيل: إذا كان مفرداً، فهو نَجِسُ العين، وإذا خالطه غيره تنجس به، فأمكن تطهيره بالغسل، فصار كالثوب النَّجِسِ، ولهذا يجوز بيع الدُّهْن المتنجِّس على أحد القولين دون دهن الميتة. قيل: لا ريبَ أنَّ هذا هو الفرق الذي عَوَّل عليه المفرِّقون بينهما، ولكنه ضعيف لوجهين. أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمد، ولا عن الشافعى البتة غسل الدهن النجِّس، وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ، وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين، وقد رُوى عن مالك، أنه يَطْهُر بالغسل، هذه رواية ابن نافع، وابن القاسم عنه. الثانى: أن هذا الفرق وإن تأتَّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما، فلا يتأتَّى لهم في جميع الأدهان، فإن منها ما لا يُمكن غسله، وأحمد والشافعى قد أطلقا القولَ بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق. وأيضاً فإنَّ هذا الفَرْق لا يُفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة، سواء كانت عينيةً أو طارئةً، فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث، فلا فرق، وإن حرم لأجل دُخان النجاسة، فلا فرق، وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه، فلا فرق، فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دونَ هذا لا معنى له. وأيضاً فقد جوز جمهورُ العلماءِ الانتفاعَ بالسِّرقين النَّجس في عمارةِ الأرض للزَّرْع، والثمر، والبقل مع نجاسة عينِه، وملابسةِ المستعمل له أكثر من ملابسة الموقَدِ، وظهورِ أثره في البقول والزروع، والثمار، فوق ظهور أثر الوقيد، وإحالةُ النار أتم من إحالة الأرض، والهواء والشمس للسِّرقين، فإن كان التحريم لأجل دُخَان النَّجَاسَةِ، فَمن سَلَّمَ أن دُخَان النجاسةِ نجس، وبأىِّ كتاب، أم بأيَّةِ سُنَّةٍ ثبت ذلك؟ وانقلابُ النجاسةِ إلى الدٌّخَان أتمُّ من انقلابِ عينِ السرقينِ والماءِ النجس ثمراً أو زرعاً، وهذا أمر لا يُشَكُّ فيه، بل معلوم بالحسِّ والمشاهدةِ، حتى جوز بعضُ أصحاب مالك، وأبى حنيفة رحمهما اللَّه بَيْعَه، فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العَذِرةِ، لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الزِّبْل. قال اللخمىُّ: وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العَذِرةِ. وقال أشهب في الزِّبْل: المشترى أعذر فيه من البائع، يعنى في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم: لم يَعْذُر اللَّه واحداً منهما، وهما سِيَّان في الإِثم. قلت: وهذا هو الصوابُ، وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به، والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريمُ الانتفاع بها في غير ما حرَّم اللَّه ورسولُه منها كالوقيد، وإطعام الصقورِ والبُزاةِ وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزَّيْتِ النَّجس في غير المساجد، وعلى جوازِ عملِ الصابون منه، وينبغى أن يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاعِ أوسعُ من بابِ البيعِ، فليس كُلُّ مَا حَرُم بيعه حَرُمَ الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريمُ الانتفاع مِن تحريم البيع. ويدخل في تحريمِ بيعِ الميتة بيعُ أجزائها التي تحلُّها الحياة، وتُفارقها بالموت، كاللحم والشحم والعصب، وأما الشعرُ والوبرُ والصوف، فلا يدخل في ذلك، لأنه ليس بميتة، ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهورُ أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارَها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر، هذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل، والليث، والأوزاعى، والثورى، وداود، وابن المنذر، والمزنى، ومن التابعين: الحسن، وابن سيرين، وأصحاب عبد اللَّه بن مسعود، وانفرد الشافعى بالقول بنجاستها، واحتجَّ له بأن اسمَ الميتة يتناولُها كَما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظر، أما الأثرُ، ففى (الكامل) لابن عدى: من حديث ابن عمر يرفعه: (ادْفِنوا الأَظْفَارَ، والدَّمَ والشَّعَرَ، فَإنَّها مَيْتَةٌ). وأما النظر، فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه، فينجس بالموت كسائر أعضائه، وبأنه شعر نابت في محل نجس، فكان نجساً كشعر الخنزير، وهذا لأن ارتباطه بأصله خِلقة يقتضى أن يثبت له حكمُه تبعاً، فإنه محسوب منه عرفاً، والشارع أجرى الأحكامَ فيه على وفق ذلك، فأوجب غسله في الطهارة، وأوجبَ الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء، وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاقِ حلاً وحرمة، وكذلك ههنا، وبأن الشارعَ له تشوف إلى إصلاح الأموالِ وحفظها وصيانتها، وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: (هلاَّ أَخَذْتُم إهَابهَا فَدَبَغْتُمُوه فَانْتَفَعْتُم بِهِ). ولو كان الشعر طاهراً، لكان إرشادُهم إلى أخذه أولى، لأنه أقلُّ كلفة، وأسهل تناولاً. قال المطهِّرُونَ للشعور: قال اللَّه تعالى: (إنَّما حَرُمَ لَحْمُهَا). وهذا ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحم، والشحمُ، والكبدُ والطحال، والألية كُلُّها داخلة في اللحم، كما دخلت في تحريم لحم الخنزير، ولا ينتقِضُ هذا بالعظم والقَرن، والظفر والحافِر، فإن الصحيحَ طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة. قالوا: ولأنه لو أُخِذَ حال الحياة، لكان طاهراً فلم ينجس بالموت كالبيض، وعكسه الأعضاء. قالُوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع دل على أنه ليس جزءاً مِن الحيوان، وأنه لا روح فيه لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ما أُبِينَ مِنْ حَىٍّ، فَهُوَ مَيْتَةٌ)، رواه أهل السنن. ولأنه لا يتألَّم بأخذه، ولا يُحس بمسه، وذلك دليلُ عدم الحياة فيه، وأما النماء، فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجَّس الحيوان بمفارقتها، فإن مجرد النماء لو دلَّ على الحياة، ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة، لتنجس الزرعُ بُيبسه، لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له. قالوا: فالحياةُ نوعان: حياة حس وحركة، وحياة نمو واغتذاء، فالأولى: هي التي يُؤثر فقدُها في طهارة الحى دون الثانية. قالوا: واللحمُ إنما ينجُس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه، والشعورُ والأصواف بريئة مِن ذلك، ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. قالوا: والأصلُ في الأعيان الطهارة، وإنما يطرأ عليها التنجيس بإستحالتها، كالرجيع المستحيل عن الغذاء، وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباهها، والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة، ثم لم يعرض لها ما يُوجب نجاستَها بخلاف أعضاء الحيوان، فإنها عرض لها ما يقتضى نجاستها، وهو احتقانُ الفضلات الخبيثة. قالوا: وأما حديثُ عبد اللَّه بن عمر، ففى إسنادِه عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد. قال أبو حاتم الرازى: أحاديثُه منكرة ليس محله عندى الصدق، وقال على بن الحسين بن الجنيد: لا يُساوى فلساً، يُحدث بأحاديث كذب. وأما حديثُ الشاة الميتة، وقوله: (ألا انتفعتم بإهابها)، ولم يتعرض للشعر فعنه ثلاثةُ أجوبة: أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإهاب، ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر، مع أنه لا بُدَّ فيه من شعر، وهو صلى الله عليه وسلم لم يُقيد الإهابَ المنتفع به بوجه دون وجه، فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. والثانى: أنه صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إلى الانتفاعِ بالشعر في الحديث نفسِه حيث يقول: (إنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُها أَوْ لحْمُها). والثالث: أن الشعرَ ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث، لأنه لا يحلُّه الموتُ وتعليلُهم بالتبعية يبطلُ بجلد الميتة إذا دُبغَ، وعليه شعر، فإنه يطهرُ دونَ الشعر عندهم، وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبْطُلُ بالجبيرة، وتمسكهم بضمانه مِن الصيد يبطُل بالبيض، وبالحمل. وأما في النكاح، فإنه يتبع الجملة لاتصاله، وزوال الجملة بإنفصاله عنها، وههنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس، لم يُفارقها فيه عندهم، فعلم الفرق. فإن قيل: فهل يدخُل في تحريم بيعها تحريمُ بيع عظمها وقرنها وجلدها بعدَ الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيعُه منها هو الذي يحرم أكلُه واستعمالُه، كما أشار إليه النبىُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: (إنَّ اللَّه تَعَالى إذَا حَرَّمَ شيئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ). وفى اللفظ الآخر: (إذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَىءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ). فنَّبه على أن الذي يحرم بيعهُ يحرم أكله. وأما الجلد إذا دبغ، فقد صار عيناً طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش، وسائِر وجوه الاستعمال، فلا يمتنع جوازُ بيعه، وقد نص الشافعى في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعُه، واختلف أصحابُه، فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهرُه دون باطنه، وقال بعضُهم: لا يجوز بيعُه، وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد، فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة، فلا يجوزُ بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضُهم: بل يجوزُ بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة يُنتفع بها فجاز بيعها كالمذكَّى، وقال بعضهم: بل هذا ينبنى على أن الدبغ إزالة أو إحالة، فإن قلنا: إحالة، جاز بَيعُه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى، وإن قلنا: إزالة، لم يجزء بيعُه، لأن وصف الميتة هو المحرمُ لبيعه، وذلك باق لم يستحل. وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله، ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاً، وتحريمه مطلقاً، والتفصيلُ بين جلد المأكول وغير المأكول، فأصحاب الوجه الأول، غلَّبُوا حكم الإحالة، وأصحاب الوجه الثانى، غلَّبوا حكم الإزالة، وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغَ مجرى الذكاة، فأباحوا بها ما يُباح أكله بالذكاة إذا ذكى دون غيره، والقولُ بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة، ولهذا لم يُمكن قائلُه القول به إلا بعد منعه كونَ الجلد بعد الدبغ ميتة، وهذا منع باطل، فإنه جلد ميتة حقيقة وحساً وحكماً، ولم يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة، وكون الدبغ إحالةً باطل حساً، فإن الجلد لم يستحل ذاتُه وأجزاؤه، وحقيقته بالدباغ، فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى، كما تُحيل النارُ الحطب إلى الرماد، والملاَّحة ما يُلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة. وأما أصحاب مالك رحمه اللَّه ففى (المدونة) لابن القاسم المنعُ من بيعها وإن دبغت، وهو الذي ذكره صاحب (التهذيب). وقال المازَرى: هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهرُ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة، فإنا نُجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهرُه وباطنُه، وبها قال وهب، وعلى هذه الرواية جوز أصحابُه بيعه والثانية: وهى أشهر الروايتين عنه أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعمالُه في اليابسات، وفى الماء وحده دون سائر المائعات، قال أصحابه: وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعُه، ولا الصلاة فيه، ولا الصلاةُ عليه. وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان، هكذا أطلقهما الأصحابُ، وهما عندى مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ. وأما بيعُ الدهن النجس، ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه. أحدها: أنه لا يجوز بيعه. والثانى: أنه يجوز بيعُه لكافر يعلم نجاسته، وهو المنصوص عنه. قلت: والمراد بعلم النجاسة: العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته. والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده، وخرج أيضاً من طهارته بالغسل، فيكون كالثوب النجس، وخرج بعضُ أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد مِن بيع الزيت النجس له، وهو تخريجٌ صحيح. وأما أصحاب أبى حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره، ومنعوه إذا كان مفرداً. وأما عظمُها، فمن لم ينجسه بالموت، كأبى حنيفة، وبعض أصحاب أحمد، واختيار ابن وهب من أصحاب مالك، فيجوز بيعُه عندهم، وإن اختلف مأخذ الطهارة، فأصحاب أبى حَنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة، ولا يتناولُه اسمها، ومنعوا كونَ الألم دليلَ حياته، قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظم، وحملوا قوله تعالى: فمأخذ الطهارة أن سببَ تنجيس الميتة منتفٍ في العظام، فلم يُحكم بنجاستها، ولا يصح قياسها على اللحم، لأن احتقانَ الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دونَ العظام، كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، وهو حيوان كامل، لِعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى، وهذا المأخذُ أصح وأقوى من الأول، وعلى هذا، فيجوز بيعُ عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين. وأما من رأى نجاستها، فإنه لا يجوز بيعها، إذ نجاستها عينية، قال ابن القاسم: قال مالك: لا أري أن تُشترى عِظام الميتة ولا تباع، ولا أنياب الفيل، ولا يتجر فيها، ولا يمتشط بأمشاطها، ولا يدهن بمداهنها، وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته الميتة، وهى مبلولة، وكره أن يُطبخ بعظام الميتة، وأجاز مطرِّف، وابن الماجِشون بيعَ أنياب الفيل مطلقاً، وأجازه ابن وهب، وأصبغ إن غُليت وسُلِقت، وجعلا ذلك دباغاً لها. وأما تحريمُ بيع الخنزير، فيتناولُ جملته، وجميعَ أجزائه الظاهرة والباطنة، وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكلِه دونَ ما قبله، بخلاف الصيد، فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد، بل حرم نفس الصيد، ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا لما حرم البيع ذكر جملته، ولم يخص التحريمَ بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً. وأما تحريمُ بيع الأصنام، فُيستفاد منه تحريمُ بيع كُلِّ آلة متخذة للشرك على أى وجه كانت، ومن أى نوع كانت صنماً أو وثناً أو صليباً، وكذلك الكُتب المشتمِلَةُ على الشرك، وعبادة غير اللَّه، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعُها ذريعةٌ إلي اقتناعها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع مِن كل ما عداها، فإن مفسدةَ بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبىُّ صلى الله عليه وسلم لم يُؤخر ذِكرها لخفة أمرها، ولكنه تدرَّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه، فإن الخمرَ أحسنُ حالاً مِن الميتة، فإنها تصيرُ مالاً محترماً إذا قلبها اللَّهُ سبحانه ابتداء خّلاً، أو قلبها الآدمى بصنعته عند طائفة من العلماء، تُضمن إذا أتلفت على الذمى عند طائفة بخلاف الميتة، وإنما لم يجعل اللَّه في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله اللَّه في الطباع مِن كراهتها والنفرة عنها، وإبعادها عنها، بخلاف الخمر. والخنزير أشدُّ تحريماً من الميتة، ولهذا أفرده اللَّه تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله: (بالفاء) و(إنَّ) تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفوسُ عنه، ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه، واستطابته، فنفى عنه ذلك، وأخبر أنه رجس، وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم لأن كونهما رجساً أمر مستقر معلوم عندهم، ولهذا في القرآن نظائر، فتأملها. ثم ذكر بعدُ تحريمُ بيع الأصنام، وهو أعظمُ تحريماً وإثماً، وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. وفى قوله: (إنَّ اللَّه إذا حَرَّم شَيْئاً أو حَرَّم أكل شَىءٍ حَرَّمَ ثمنه)، يُراد به أمران، أحدهُما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. والثانى: ما يُباح الانتفاعُ به في غير الأكل، وإنما يحرم أكلُه، كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكلُه دونَ الانتفاع به، فهذا قد يُقال: إنه لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه، ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه، فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما، حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره، وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به، حل ثمنه. وإذا بيع لأكله، حرم ثمنه، وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء، كأحمد، ومالك وأتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمراً، حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، وكذلك السلاحُ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماً، حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل اللَّه، فثمنه من الطيبات، وكذلك ثيابُ الحرير إذا بيعت لمن يلبسُها ممن يحرم عليه، حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. فإن قيل: فهل تُجوِّزون للمسلم بيعَ الخمر والخنزير مِن الذمى لاعتقاد الذمى حلهما، كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ قيل: لا يجوز ذلك، وثمنُه حرام، والفرقُ بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة، ويسوغ فيها النزاعُ. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغير، فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل، بخلاف العين التي حرمها اللَّه في كُلِّ ملة، وعلى لسان كل رسول، كالميتة، والدم، والخنزير، فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسلُ على تحريمه، وإن اعتقد الكافرُ حِلَّه، فهو كبيع الأصنام للمشركين، وهذا هو الذي حرَّمه اللَّه ورسولُه بعينه، وإلا فالمسلمُ لا يشترى صنماً. فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب، فجوَّزوا بيعها منهم. قيل: هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، حتى كتب إليهم عمر رضى اللَّه عنه ينهاهم عنه، وأمر عماله أن يُولوا أهل الكتاب بَيعها بأنفسهم، وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها، فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى، عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، أن ناساً يأخذون الجزية من الخنازير، فقام بلال، فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر رضى اللَّه عنه: لا تفعلُوا، ولُّوهم بيعها. قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصارى، عن إسرائيل، عن إبراهيم ابن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أن بلالاً قال لعمر رضى اللَّه عنه: إن عُماَلك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن. قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير مِن جزية رؤوسهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى المسلمون بيعها، فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمرُ، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهلُ الذمة هم المتولين لبيعها، لأن الخمر والخنازير مالٌ من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالاً للمسلمين. قال: ومما يُبين ذلك حديثُ آخرُ لعمر رضى اللَّه عنه حدثنا على ابن معبد، عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن ليث بن أبى سليم، أن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية مِن جزيتهم. قال أبو عُبيد: فهو لم يجعلها قِصاصاً من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم. فأما إذا مر الذمى بالخمر والخنازير على العاشر، فإنه لا يطيبُ له أن يُعشِّرها، ولا يأخذ ثمن العشر منها. وإن كان الذمى هو المتولى لبيعها أيضاً، وهذا ليس مِن الباب الأول، ولا يشبهه، لأن ذلك حقٌ وجب على رقابهم وأرضيهم، وأن العشر ههنا إنما هو شىء يُوضع على الخمر والخنازير أنفسها، وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن اللَّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه). وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، أنه أفتى في مثلِ هذا بغير ما أفتى به في ذاك، وكذلك قال عمرُ بن عبد العزيز. حدثنا أبو الأسود المصرى، حدثنا عبدُ اللَّه بن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة السَّبَائِى أن عُتبة بن فرقد بعث إلى عمرَ بنِ الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر رضى اللَّه عنه: بعثت إلىَّ بصدَقِة الخمر، وأنت أحقُّ بها من المهاجرين، وأخبرَ بذلك الناس، وقال: واللَّه لا استعملتُك على شىءِ بعدها، قال: فتركه. حدثنا عبد الرحمن، عن المثنى بن سعيد الضبعى، قال: كتب عمرُ بن عبد العزيز إلى عدىِّ بن أرطاة، أن ابعث إلىَّ بتفصيل الأموال التي قِبلَك، من أين دخلت؟ فكتبَ إليه بذلك وصنفه له، وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءَ اللَّه، ثم جاءه جوابُ كتابه: إنك كتبتَ إلىَّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم، وإن الخمر لا يُعشرها مسلم، ولا يشتريها، ولا يبيعُها، فإذا أتاك كتابى هذا، فاطلب الرجلَ، فاردُدْها عليه، فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرجل، فَرَدَّتْ عليه. قال أبو عُبيد: فهذا عندى الذي عليه العمل، وإن كان إبراهيم النخعى قد قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمى يمرُّ بالخمر على العاشر، قال: يضاعف عليه العشور. قال أبو عُبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مُرَّ على العاشر بالخمر والخنازير، عَشَّرَ الخمر، ولم يُعشِّرِ الخنازيرَ، سمعتُ محمد بن الحسن يُحدِّث بذلك عنه، قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز رضى اللَّه عنهما أولى بالاتباع، واللَّه أعلم.
في (الصحيحين): عن أبى مسعود، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ ثَمَن الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِىِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ. وفى صحيح مسلم: عن أبى الزبير، قال: سألتُ جابراً عن ثمن الكلب والسِّنور فقال: زَجَرَ النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفى سنن أبى داود: عنه أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ. وفى صحيح مسلم: من حديث رافع بن خَديج، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ البَغِىّ وثَمَنُ الكَلْبِ وكَسْبُ الحَجَّامِ). فتضمنت هذه السنن أربعة أمور. أحدُها: تحريمُ بيع الكلب، وذلك بتناولُ كل كلب صغيراً كانَ أو كبيراً للصيد، أو للماشية، أو للحرث، وهذا مذهبُ فقهاءِ أهلِ الحديثِ قاطبة، والنزاعُ في ذلك معروف عن أصحاب مالك، وأبى حنيفة، فجوز أصحابُ أبى حنيفة بيعَ الكلاب، وأكل أثمانها، وقال القاضى عبد الوهَّاب: اختلف أصحابُنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يُكره، ومنهم من قال: يَحرم، انتهى. وعقدَ بعضُهم فصلاً لما يصح بيعُه، وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب، فقال: ما كانت منافعُه كلُّها محرمة لم يجز بيعه، إذ لا فرق بين المعدوم حساً، والممنوع شرعاً، وما تنوَّعَتْ منافِعُه إلى محللة ومحرمة، فإن كان المقصودُ مِن العين خاصة كان الاعتبارُ بها، والحكم تابع لها، فاعتُبِرَ نوعُها، وصار الآخر كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين، لم يَصِحَّ البيعُ، لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل، وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً. قال: وعلى هذا الأصل مسألةُ بيعِ كلب الصيد، فإذا بُنى الخلافُ فيها على هذا الأصل، قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذا، وعُددت جملة منافعه، ثم نظر فيها، فمن رأى أن جملتها محرمة، منع، ومن رأى جميعَها مُحَلَّلَة، أجاز، ومن رآها متنوعة، نظر: هل المقصودُ المحلل، أو المحرم، فجعل الحكمَ للمقصود، ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهى مقصودة، منع أيضاً، ومن التبس عليه كونُها مقصودة، وقف أو كره، فتأمل هذا التأصيلَ والتفصيل، وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما مِن التناقض والخلل، وأن بناءَ بيع كلب الصيد على هذا الأصل مِن أفسد البناء، فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها، لم يجز بيعُه، فإن هذا لم يقله أحدٌ من الناس قط، وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة، وهما جُلُّ منافعه، ولا يُقتنى إلا لذلك، فمن الذي رأى منافعه كُلَّها محرمة، ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية؟ فإن إعارتَه جائزة. وقوله: ومن رأى جميعها محللة، أجاز، كلامٌ فاسِدٌ أيضاً، فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقاً، والجمهور على عدم جواز بيعه.وقوله: ومن رآها متنوعة، نظر، هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلامٌ لا فائدة تحته البتة، فإن منفعةَ كلب الصيد هي الاصطيادُ دون الحراسة، فأين التنوعُ وما يُقدَّرُ في المنافع من التحريم يُقدَّرُ مثلُه في الحمار والبغل؟ وقوله: ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهى مقصودة، منع. أظهرُ فساداً مما قبله، فإن هذه المنفعةَ المحرمة ليست هي المقصودةَ من كلب الصيد، وإن قُدِّرَ أن مشتريَه قصدها، فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه، وتبين فساد هذا التأصيل، وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النصُّ الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه. فإن قيل: كلبُ الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه الترمذى، من حديث جابر رضى اللَّه عنه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، إلا كلبَ الصَّيْدِ. وقال النسائى: أخبرنى إبراهيم بن الحسن المصيصى، حدثنا حجاج ابن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر رضى اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ، إلا كلبَ الصيد. وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابنُ أبى مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا المثَّنى بن الصبَّاح، عن عطاء بن أبى رباح، عن أبى هُريرة رضى اللَّه عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (ثَمَنُ الكَلْبِ سُحْتٌ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ). وقال ابن وهب عَمَّن أخبره، عن ابن شهاب، عن أبى بكر الصِّديق رضى اللَّه عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ثَلاثٌ هُنَّ سحْتٌ: حُلْوانُ الكاهِنِ، ومَهْرُ الزانِية، وثَمَنُ الكلبِ العَقُور). وقال ابن وهب: حدثنى الشِّمْرُ بن عبد اللّتَه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه، أنَّ النَبىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ العَقُورِ. ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضاً، أن جابراً أحد من روى عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم النهىَ عن ثمنِ الكلب، وقد رخَّص جابر نفسُه في ثمن كلب الصيد، وقولُ الصحابى صالح لتخصيص عمومِ الحديث عند من جعله حجة، فكيف إذا كان معه النصُّ بإستثنائه والقياس؟ وأيضاً لأنه يُباح الانتفاع به، ويَصِحُّ نقلُ اليد فيه بالميراث، والوصية، والهبة، وتجوزُ إعارته وإجارته في أحد قولى العلماء، وهما وجهان للشافعية، فجاز بيعه كالبغل والحمار. فالجواب: أنه لا يَصِحُّ عن النبى صلى الله عليه وسلم استثناءُ كلب الصيد بوجه: أما حديث جابر رضى اللَّه عنه، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا مِن الحسن بن أبى جعفر، وهو ضعيف، وقال الدارقطنى: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذى: لا يصح إسناد هذا الحديث. وقال في حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه: هذا لا يصح، أبو المهزِّم ضعيف، يريد روايه عنه. وقال البيهقى: روى عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم النهىَ عن ثمن الكلب جماعةٌ، منهم: ابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وأبو جُحيفة، اللفظ مختلف، والمعنى واحد. والحديث الذي روُى في استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهى عن اقتنائه، فَشُبِّهَ عليه، واللَّه أعلم. وأما حديثُ حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، فهو الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه اللَّه بالحسن بن أبى جعفر، وكأنَّه لم يقع له طريق حجاج ابن محمد، وهو الذي قال فيه الدارقطنى: الصواب أنه موقوف، وقد أعله ابن حزم، بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر، وهو مدلس، وليس من رواية الليث عنه. وأعلَّه البيهقىُّ بأن أحدَ رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نُهِىَ عن اقتنائه من الكلاب، فنقله إلى البيع. قلت: ومما يدل على بطلانِ حديثِ جابر هذا، وأنه خُلِّطَ عليه أنه صَحّ عنه، أنه قال: أربعٌ من السحت: ضِرَابُ الفَحْل، وثمنُ الكلب، ومَهْرُ البغىِّ، وكسب الحجام. وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد، فهو علة للموقوف والمرفوع. وأما حديثُ المثَّنى بن الصبَّاح، عن عطاء، عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه، فباطل، لأن فيه يحيى بن أيوب، وقد شهد مالك عليه بالكذب، وجرَّحه الإمام أحمد. وفيه المثنى بن الصباح، وضعفه عندهم مشهور، ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائى، حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب، حدثنا محمدبن عبد اللَّه بن نمير حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش، عن عطاء بن أبى رباح، قال: قال أبو هريرة رضى اللَّه عنه: أربعٌ مِن السُّحت، ضِرَابُ الفَحْلِ، وثَمَنُ الكَلْبِ، ومَهْرُ البَغىِّ، وكَسْبُ الحَجَّامِ. وأما الأثر عن أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنه، فلا يُدرى من أخبر ابنَ وهب عن ابن شهاب، ولا من أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضى اللَّه عنه، ومثل هذا لا يُحتج به. وأما الأثرُ عن على رضى اللَّه عنه: ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف، ومثلُ هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تُقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاتُ الأثبات، حتى قال بعضُ الحفاظ: إن نقلها نقلُ تواتر، وقد ظهر أنه لم يَصِحَّ عن صحابى خلافها البتة، بل هذا جابر، وأبو هريرة، وابن عباس يقولون: ثمنُ الكلب خبيث. قال وكيع: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَرٍ، عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما يرفعه: (ثَمَنُ الكَلْبِ، ومَهْرُ البَغِىِّ، وثَمَنُ الخَمْرِ حَرَامٌ). وهذا أقل ما فيه أن يكون قولَ ابن عباس. وأما قياسُ الكلب على البغل والحمار، فمن أفسد القياس، بل قياسُه على الخنزير أصحُّ من قياسه عليهما، لأن الشبَه الذي بينه وبَين الخنزير أقربُ مِن الشبه الذي بينَه وبينَ البغل والحمار، ولو تعارض القياسانِ لكان القياسُ المؤيَّد بالنصِّ الموافق له، أصحَّ وأولى من القياس المخالف له. فإن قيل: كان النهىُ عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلها، فلما حَرُمَ قتلُها، وأبيحَ اتخاذُ بعضها، نُسِخَ النهىُ، فنسخ تحريمُ البيع. قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل، ولا شُبهة، وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى البتة بوجه من الوجوه، ويدل على بطلانها: أن أحاديثَ تحريمِ بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كُلّها، وأحاديثُ الأمر بقتلها، والنهى عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم، ونوع مقيَّد مخصص وهو المتأخر، فلو كان النهى عن بيعها مقيداً مخصوصاً، لجاءت به الآثارُ كذلك، فلما جاءت عامة مطلقة، عُلثمَ أن عمومَها وإطلاقَها مراد، فلا يجوز إبطالُه. واللَّه أعلم. الحكم الثانى: تحريمُ بيع السِّنور، كما دل عليه الحديثُ الصحيح الصريح الذي رواه جابر، وأفتى بموجبه، كما رواه قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضَّاح، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا عبد اللَّه بن المبارك، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه، أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد اللَّه، أنه كره بما رواه، ولا يُعرف له مخالف مِن الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة رضى اللَّه عنه، وهو مذهبُ طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهى اختيارُ أبى بكر عبد العزيز، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يُعارضه، فوجب القولُ به. قال البيهقى: ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوماً بنجاستها، فلما قال النبى ُّ صلى الله عليه وسلم: (الهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ). صار ذلك منسوخاً في البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا توحَّش، ومتابعة ظاهر السنة أولى. ولو سمع الشافعى رحمه اللَّه الخبر الواقع فيه، لقال به إن شاء اللَّه، وإنما لا يقول به مَنْ توقَّف في تثبيت روايات أبى الزبير، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس، وحفص بن غياث عن الأعمش، عن أبى سفيان انتهى كلامه. ومنهم من حمله على الهرِّ الذي ليس بمملوك، ولا يخفى ما في هذه المحامل مِن الوهن. والحكم الثالث: مهر البغى، وهو ما تأخذُه الزانية في مقابل الزنى بها، فحكم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ذلك خبيثٌ على أى وجه كان، حرةً كانت أو أمةً، ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر، ولهذا قالت هند: وقت البيعة: (أو تزنى الحُرة؟) ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهرَ لها. واختلف في مسألتين. إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة، فأما الحرة المكرهة على الزنى، ففيها أربعة أقوال، وهى روايات منصوصات عن أحمد. أحدها: أن لها المهر بكراً كانت أو ثيباً، سواء وطئت في قبلها أو دبرها. والثانى: أنها إن كانت ثيباً، فلا مهر لها، وإن كانت بكراً، فلها المهرُ، وهل يجب معه أرشُ البكارة؟ على روايتين منصوصتين، وهذا القولُ اختيارُ أبى بكر. والثالث: أنها إن كانت ذاتَ محرم، فلا مهر لها، وإن كانت أجنبية، فلها المهر. الرابع: أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت، فلا مهر لها، ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة، فلها المهر. وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: لا مهر للمكرهة على الزنى بحال، بكراً كانت أو ثيباً. فمن أوجب المهر. قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع بالمهر، وإنما لم يجب للمختارة، لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها، فلم يجب لها شىء، كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. ومن لم يُوجبه قال: الشارعُ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهرِ في عقد أو شبهة عقد، ولم يُقومها بالمهر في الزنى البتة، وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس. قالوا: وإنما جعل الشارعُ في مقابلة هذا الاستمتاع الحدَّ والعُقوبة، فلا يجمع بينَه وبينَ ضمان المهر. قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من الشرع من نص خطابه أو عمومه، أو فحواه، أو تنبيهه، أو معنى نصِّه، وليس شىء من ذلك ثابتاً متحققاً عنه. وغاية ما يُدعى قياسُ السفاح على النكاح، ويا بُعد ما بينهما. قالوا: والمهر إنما هو مِن خصائص النكاح لفظاً ومعنى، ولهذا إنما يُضاف إليه فيقال: مهر النكاح، ولا يُضاف إلى الزنى، فلا يقال: مهر الزنا، وإنما أطلق النبى صلى الله عليه وسلم المهر وأراد به العقد، كما قال: (إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والميْتَةِ والخِنزِيرِ والأَصْنَامِ). وكما قال: (ورَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأكَلَ ثَمَنَهُ). ونظائرُه كثيرة. والأولون يقولون: الأصلُ في هذه المنفعة، أن تقوَّم بالمهر، وإنما أسقطه الشارعُ في حق البغى، وهى التي تزنى بإختيارها، وأما المكرهة على الزنى فليست بغياً، فلا يجوز إسقاطُ بدلِ منفعتها التي أُكرهت على استيفائها، كما لو أُكرِهَ الحر على استيفاء منافعه، فإنه يلزمُه عوضها، وعوضُ هذه المنفعة شرعاً هو المهر، فهذا مأخذ القولين. ومن فرَّق بين البكر والثيب، رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئاً، وحسبُه العقوبة التي ترتبت على فعله، وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً مال يلزم من أقدم عليها، بخلاف البكر، فإنه أزال بكارتها، فلا بُد من ضمان ما أزاله، فكانت هذه الجنايةُ مضمونةً عليه في الجملة، فضمن ما أتلفه مِن جزء منفعة، وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان، كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة. ومن فرَّق بين ذوات المحارم وغيرهن، رأى أن تحريمهن لما كان تحريماً مستقراً، وأنهن غيرُ محل الوطء شرعاً، كان استيفاءُ هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط، فلا يوجب مهراً وهذا قولُ الشعبى، وهذا بخلاف تحريم المصاهرة، فإنه عارض يُمكن زوالُه. قال صاحب (المغنى): وهكذا ينبغى أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع، لأَنَِّهُ طَارىءُ أيضاً. ومن فرَّق في ذوات المحارم، بينَ مَنْ تحرم ابنتها، وبين من لا تحرُم، فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف مِن تحريم الأخرى، فأشبه العارض. فإن قيل: فما حكمُ المكرهة على الوطء في دُبرها، أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب، فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً. وقد اختلف في هذه المسألة الشيخانِ، أبو البركات ابن تيمية، وأبو محمد بن قدامة، فقال أبو البركات في (محرره): ويجب مهرُ المثل للموطوءة بشبهة، والمكرَهَة على الزنى في قبل أو دبر، وقال أبو محمد في (المغنى): ولا يجب المهرُ بالوطء في الدبر، ولا اللواط، لأن الشرع لم يَرِدُ ببَدَلِه، ولا هو إتلافٌ لشىء، فأشبه القبلة والوطءَ دونَ الفرج، وهذا القولُ هو الصوابُ قطعاً، فإن هذا الفعل لم يجعل له الشارعُ قيمة أصلاً، ولا قدَّر له مهراً بوجه من الوجوه، وقياسُه على وطء الفرج مِن أفسد القياس، ولازم من قاله إيجابُ المهر لمن فعلت به اللوطية مِن الذكور، وهذا لم يقل به أحد البتة. وأما المسألة الثانية: وهى الأمة المطاوعة، فهل يجب لها المَهر؟ فيه قولان. أحدُهما: يِجبُ، وهو قولُ الشافعى، وأكثر أصحاب أحمد رحمه اللَّه. قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرها، فلا يسقط بدلها مجاناً، كما لو أذنت في قطع طرفها. والصوابُ المقطوع به: أنه لا مهر لها، وهذه هي البغىُّ التي نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مهرها، وأخبر أنه خبيثٌ، وحكم عليه وعلى ثمنِ الكلب، وأجرِ الكاهن بحكم واحد، والأمة داخلة في هذا الحكم دخولاً أولياً، فلا يجوز تخصيصُها مِن عمومه لأن الإماء هن اللاتى كُن يُعرفن بالبغاء، وفيهن وفى ساداتهن أنزل اللَّهُ تعالى: وأما قولكم: إن منفعتها لسيدها، ولم يأذن في استيفائها، فيقال: هذه المنفعةُ يملك السيدُ استيفاءها بنفسه، ويملِكُ المعاوضة عليها بعقد النكاحِ أو شبهته، ولا يملِكُ المعاوضَةَ عليها إلا إذا أذنت، ولم يجعل اللَّهُ ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبة، فيفوت على السيد حتى يُقضى له، بل هذا تقويمُ مال أهدره اللَّهُ ورسولُه، وإثباتُ عِوض حكم الشارعُ بخبثه، وجعله بمنزلة ثمنِ الكلب، وأجرِ الكاهن، وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً، لم يجز أن يقضى به. ولا يقال: فأجر الحجام خبيث، ويُقضى له به، لأن منفعة الحِجامة منفعة مباحة، وتجوز، بل يجبُ على مستأجره أن يُوفيه أجره، فأين هذا مِن المنفعة الخبيثة المحرمة التي عِوضها مِن جنسها، وحُكمه حكمها، وإيجابُ عوض في مقابلة هذه المعصية، كإيجابِ عوض في مقابلة اللواط، إذ الشارع لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضاً. فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاً، وهو المهرُ مِن حيث الجملة، بخلاف اللواطة. قلنا: إنما جعل في مقابلته عوضاً، إذا استوفى بعقد أو بشبهة عقد، ولم يجعل له عوضاً إذا استوفى بزنى محض لا شُبهة فيه، وباللَّه التوفيق. ولم يُعرف في الإسلام قط أن زانياً قضى عليه بالمهر للمزنى بها، ولا ريبَ أن المسلمين يرون هذا قبيحاً، فهو عند اللَّه عز وجل قييح. فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته، ثم تابت، هل يجبُ عليها ردُّ ما قبضته إلى أربابه، أم يطيبُ لها، أم تصَّدق به؟ قيل: هذا ينبنى على قاعدة عظيمة مِن قواعد الإسلام، وهى أن مَن قبض ما ليس له قبضُه شرعاً، ثم أراد التخلصَ منه، فإن كان المقبوضُ قد أُخِذَ بغير رضى صاحبه، ولا استوفى عِوضَه، ردَّه عليه. فإن تعذَّر ردُّه عليه، قضى به ديناً يعلمه عليه، فإن تعذَّر ذلك، رده إلى ورثته، فإن تعذَّر ذلك، تصدق به عنه، فإن اختار صاحبُ الحق ثوابَه يوم القيامة، كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ مِن حسنات القابض، استوفى منه نظيرَ ماله، وكان ثوابُ الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت عن الصحابة رضى اللَّه عنهم. وإن كان المقبوضُ برضى الدافع وقد استوفى عِوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجبُ ردُّ العوض على الدافع، لأنه أخرجه بإختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوزُ أن يجمع له بينَ العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصى عليه. وماذا يريد الزانى وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه، ويسترِد ماله، فهذا مما تُصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغُ القولُ به، وهو يتضمن الجمْع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيحِ أن يستوفى عوضه من المزنى بها، ثم يرجع فيما أعطاها قهراً، وقبح هذا مستقر في فِطر جميع العقلاء، فلا تأتى به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريقُ التخلص منه، وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجاً إليه، فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقى، فهذا حكمُ كل كسب خبيث لِخبث عوضه عيناً كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبُ رده على الدافع، فإن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بخُبثِ كسبِ الحجام، ولا يجب ردُّه على دافعه. فإن قيل: فالدافع مَالَه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوزُ دفعه، بل حجر عليه فيه الشارع، فلم يقع قبضُه موقعه، بل وجودُ هذا القبض كعدمه، فيجب ردُّه على مالكه، كما لو تبرع المريضُ لوارثه بشىء، أو لأجنبى بزيادة على الثلث، أو تبرَّْع المحجورُ عليه بفلس، أو سفه، أو تبرع المضطرُ إلى قوته بذلك، ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محجورٌ عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب ردُّه. قيل: هذا قياس فاسد، لأن الدفع في هذه الصور تبرعٌ محض لم يُعاوض عليه، والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به، أو حق نفسه المقدمة على غيره، وأما نحن فيه، فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة، أو استهلاك عينٍ محرمة، فقد قبض عوضاً محرماً، وأقبض مالاً محرماً، فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه، وبذل فيه ما لا يجوزُ بذلُه، فالقابضُ قبض مالاً محرماً، والدافعُ استوفى عِوضاً محرماً، وقضيةُ العدل ترادُّ العوضين، لكن قد تعذر ردُّ أحدهما، فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه، أو دفع إليها المال ولم يفجر بها، وجب ردُّ المال في الصورتين قطعاً كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبضُ. فإن قيل: وأىُّ تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة، ومعلوم أن قبضَ ما لا يجوز قبضُه بمنزلة عدمه، إذ الممنوعُ شرعاً كالممنوع حساً، فقابضُ المال قبضه بغير حق، فعليه أن يَرُدَّهُ إلى دافعه؟ قيل: والدافع قبض العين، واستوفى المنفعة بغير حق، كلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس لهما دفعه، وقبض ما ليس لهما قبضه، وكلاهما عاصٍ للَّه، فكيف يُخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، ويفوتُ على الآخر العوض والمعوض. فإن قيل: هو فوَّتَ المنفعة على نفسه بإختياره. قيل: والآخر فوَّت العوض على نفسه بإختياره، فلا فرق بينهما، وهذا واضح بحمد اللَّه. وقد توقف شيخنا في وجوب ردِّ عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله، أو الصدقة به في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)، وقال: الزانى، ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المالَ عن طيب نفوسهم، فاستوفوا العوضَ المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحقِّ اللَّه تعالى، وقد فاتت هذه المنفعةُ بالقبض، والأصول تقتضى أنه إذا رد أحدَ العوضين، ردَّ الآخر، فإذا تعذر على المستأجر ردُّ المنفعة لم يرد عليه المال، وهذا الذي استوفيت منفعتُه عليه ضرر في أخذ منفعته، وأخذ عوضها جميعاً منه، بخلاف ما إذا كان العوض خمراً أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت، لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعنى من صرف القوة التي عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاً، فقال: فيقال على هذا فينبغى أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد، ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة، لأنه كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة، فقلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتَك في عمل يحرم، فلا يُقضى لك بالأجرة. فإذا قبضها، وقال الدافع هذا المال: اقضوا لى برده، فإنى أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة، قلنا له: دفعته معاوضة رضيتَ بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ، فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهرُ القياس، ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد، انتهى. وقد نص أحمد في رواية أبى النضر، فيمن حمل خمراً، أو خنزيراً، أو ميتة لنصرانى: أكرهُ أكلَ كرائه، ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم، فهو أشدُّ كراهة. فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق. إحداها: إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة. قال ابنُ أبى موسى: وكره أحمد أن يُؤجر المسلم نفسَه لحمل ميتة أو خنزير لنصرانى. فإن فعل، قضى له بالكراء، وهل يطيبُ له أم لا؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا يطيبُ له، ويتصدَّقُ به، وكذا ذكر أبو الحسن الآمدى، قال: إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر، أو خنزير، أو ميتة، كره ؛ نص عليه، وهذه كراهة تحريم، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. إذا ثبت ذلك، فيقضى له بالكراء، وغير ممتنع أن يُقضى له بالكراء وإن كان محرماً، كإجارة الحجام انتهى. فقد صرَّح هؤلاء، بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريق الثانية: تأويلُ هذه الرواية بما يُخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة، وهى أن هذه الإجارة لا تصِح، وهذه طريقة القاضى في (المجرد)، وهى طريقة ضعيفة، وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة، فإنه صنف (المجرد) قديماً. الطريقة الثالثة: تخريجُ هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح الإجارة، ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. وهذا على قياس قوله في الخمر: لا يجوز إمساكُها، وتجب إراقتها. قال في رواية أبى طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير تُصب الخمرُ، وتسرَّحُ الخنازير، وقد حرما عليه، وإن قتلها، فلا بأس. فقد نص أحمد، أنه لا يجوز إمساكُها، ولأنه قد نصَّ في رواية ابن منصور: أنه يكره أن يُؤاجر نفسه لنطارة كرم لنصرانى، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر، فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر، وهذه طريقة القاضى في (تعليقه) وعليها أكثر أصحابه، والمنصور عندهم: الرواية المخرجة، وهى عدمُ الصحة، وأنه لا يستحق أجرة، ولا يقضى له بها، وهى مذهبُ مالك، والشافعى، وأبى يوسف، ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزير، أو مطلقاً، فأما إذا استأجره لحملها لِيُريقها، أو لينقل الميتة إلى الصحراء لئلا يتأذَّى بها، فإن الإجارة تجوزُ حينئذ لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح، واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه، رده على صاحبه، هذا قول شيخنا، وهو مذهب مالك. والظاهر: أنه مذهب الشافعى. وأما مذهب أبى حنيفة رحمه اللَّه: فمذهبه كالرواية الأولى، أنه تصح الإجارة، ويُقضى له بالأجرة، ومأخذه في ذلك، أن الحمل إذا كان مطلقاً، لم يكن المستحق نفسَ حمل الخمر، فذكرُه وعدمُ ذكره سواء، وله أن يحمل شيئاً آخر غيره كخل وزيت، وهكذا قال: فيما لو أجره داره، أو حانوته ليتخذها كنيسة، أو لبيع فيها الخمر، قال أبو بكر الرازى: لا فرق عند أبى حنيفة بين أن يشترط أن يبيعَ فيها الخمر، أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبيعُ فيه الخمر: أن الإجارة تَصِحُّ، لأنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط ذلك، لأن له أن لا يبيعَ فيه الخمر، ولا يتخذ الدار كنيسة، ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء، كان ذكرها وتركها سواء، كما لو اكترى داراً لينام فيها أو ليسكنها، فإن الأجرة تستحق عليه، وإن لم يفعل ذلك، وكذا يقول: فيما إذا استأجر رجلاً ليحمل خمراً أو ميتة، أو خنزيراً: أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمله بدلَه عصيراً استحق الأجرة، فهذا التقييدُ عندهم لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصى فيها، كما يجوز بيعُ العصير لمن يتخذه خمراً، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره، وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا: ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقودُ عليها هي المستحقةُ، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهى منفعة محرمة، وإن كان للمستأجر أن يُقيم غيرهَا مقامَها، وألزموه فيما لو اكترى داراً لِيتخذها مسجداً، فإنه يستحِقُّ عليه فعل المعقودِ عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعلَ الصلاة، وهى لا تستحقُّ بعقد إجارة. ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية، وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم، حرمت الإجارة، لأن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لعن عاصِرَ الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصِرُ عصيراً، ولكن لما علم أن المعتصِرَ يريد أن يتخذه خمراً، فيعصره له، استحق اللعنة. قالوا: وايضاً فإن في هذا معاونة على نفس ما يَسْخَطُهُ اللَّهُ ويُبغضه، ويلعنُ فاعله، فأصولُ الشرع وقواعدُه تقتضى تحريمَه وبطلان العقد عليه، وسيأتى مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم بتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة. قال شيخنا: والأشبهُ طريقةُ ابن موسى، يعنى أنه يُقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة، ولكن لا يطيبُ له أكلُها. قال: فإنها أقربُ إلى مقصود أحمد، وأقربُ إلى القياس، وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحامِلَها والمحمولة إليه. فالعاصر والحامِل، قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاً، وهى ليست محرمةً في نفسها، وإنما حَرُمَت بقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراً، وفات العصيرُ والخمر في يد المشترى، فإن مال البائع لا يذهب مجاناً، بل يُقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاناً، بل يُعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاعِ بها إنما كان من جهة المستأجر، لا من جهة المؤجر، فإنه لو حملها للإراقة، أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذى بها، جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق اللَّه سبحانه لا لحق المستأجر والمشترى، بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر، فهو كما لو باع ميتة أو خمراً، فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة، وكذلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. قال شيخنا: ومثلُ هذه الإجارة، والجعالة، يعنى الإجارة على حمل الخمر والميتة، لا تُوصف بالصحة مطلقاً، ولا بالفساد مطلقاً، بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه العوض، وفاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاعُ بالأجر، ولهذا في الشريعة نظائر. قال: ولا يُنافى هذا نصُّ أحمد على كراهة نطارة كرم النصرانى، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه، ثم نقضى له بكرائه، قال: ولو لم يفعل هذا، لكان في هذا منفعة عظيمةٌ للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينُون به على المعصية قد حصلوا غرضَهم منه، فإذا لم يعطوه شيئاً، ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم، كان ذلك أعظمَ العون لهم، وليسوا بأهلٍ أن يُعاونوا على ذلك، بخلاف من سَلَّم إليهم عملاً لا قيمة له بحال، يعنى كالزانية، والمغنى، والنائحة، فإن هؤلاء لا يُقضى لهم بأجرة، ولو قبضوا منهم المال، فهل يلزمُهم ردُّه عليهم، أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك، وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده، ولا يطيبُ لهم أكله، واللَّه الموفق للصواب. الحكم الخامس: حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف في حُلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته، وهو مِن أكل المال بالباطل، والحلوان في أصل اللغة: العطية. قال علقمةُ: فَمَنْ رَجُلٌ أَحْلُوهُ رَحْلى ونَاقَتِى يُبَلِّغُ عنِّى الشِّعْرَ إذْ مَاتَ قَائِلُهُ انتهى. وتحريمُ حُلوان الكاهن تنبيه على تحريم حُلوان المنجم، والزاجر، وصاحب القُرعة التي هي شقيقة الأزلام، وضاربة الحصا، والعرَّاف، والرَّمَّال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارُ عن المغيبات، وقد نهى النبىُّ صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهّانِ، وأخبر أن: (مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَصَدَّقه بما يَقُولُ، فَقَدْ كَفَر بِمَا أنزل عليه صلى الله عليه وسلم) ولا ريبَ أن الإيمانَ بما جاء به محَّمدٌ صلى الله عليه وسلم، وبما يجىء به هؤلاء، لا يجتمعان في قلب واحد، وإن كان أحدُهم قد يَصْدُقُ أيحاناً، فصِدقُه بالنسبة إلى كذبه قليلٌ من كثير، وشيطانُه الذي يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَصْدُقَه أحياناً لِيُغوىَ به الناس، ويفتنهم به. وأكثرُ الناسِ مستجيبون لهؤلاء، مؤمنون بهم، ولا سيما ضعفاء العقول، كالسُّفهاء، والجُهَّالِ، والنِّساء، وأهل البوادى، ومن لا عِلْمَ لهم بحقائق الإيمان، فهؤلاء هم المفتونون بهم، وكثيرٌ منهم يُحْسِنُ الظنَّ بأحدهم، ولو كان مشركاً كافراً باللَّه مجاهراً بذلك، ويزوره، وينذر له، ويلتمِسُ دعاءه. فقد رأينا وسمِعْنَا من ذلك كَثيراً، وسببُ هذا كله خفاءُ ما بعث اللَّه به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم، وأما أصحابُ الملاحم، فركَّبُوا ملاحِمَهم من أشياء. أحدها: من أخبارِ الكهان. والثانى: من أخبارٍ منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بينَ أهل الكتاب. والثالث: من أمور أخْبَرَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بها جملة وتفصيلاً. والرابع: من أمور أخبر بها من له كشف مِن الصحابة ومَن بعدهم. والخامس: من منامات متواطئة على أمر كُلى وجزئى. فالجزئى: يذكرونه بعينه والكُلى: يُفصلونه بحدس وقرائن تكون حقاً أو تقارب. والسادس: مِن استدلال بآثار علوية جعلها اللَّه تعالى علامات وأدلة وأسباباً لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرُ الناس، فإن اللَّه سبحانه لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً. وربط سبحانه العالمَ العُلوى بالسُّفلى، وجعل عُلويه مؤثراً في سُفليه دون العكسِ، فالشمس، والقمرُ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإن كان كسوفُهما لِسبب شر يحدث في الأرض، ولهذا شرع سُبحانه تغييرَ الشرِ عند كُسوفهما بما يدفع ذلك الشرَّ المتوقَّعَ مِن الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق، فإن هذه الأشياء تُعارضُ أسباب الشر، وتُقاومها، وتدفع موجباتها إن قويت عليها. وقد جعل اللَّهُ سبحانه حركةَ الشمس والقمر، واختلافَ مطالعهما سبباً للفصول التي هي سببُ الحر والبرد، والشتاء والصيف، وما يحدُث فيهما مما يليق بكُلِّ فصل منها، فمن له اعتناء بحركاتهما، واختلاف مطالعهما، يستدِلُّ بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهما، وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل الفلاحة والزراعة، ونواتى السفن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما وأحوالِ الكواكب على أسباب السلامةِ والعطبِ مِن اختلاف الرياح وقوتها وعُصوفها، لا تكاد تَخْتَلُّ. والأطباءُ لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لِقبول التغير، واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك. وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذا، وأمور متوارثَة عن قدماء المنجمين، ثم يستنتجون مِن هذا كُلِّه قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره. وسنة اللَّه في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته، فحكم النظير حكمُ نظيره، وحكمُ الشىء حكم مثله، وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاءِ والقدر، واعتبار بعضه ببعض، والاستدلال ببعضه على بعض، كما صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع، واعتبار بعضه ببعض، والاستدلال ببعضه على بعض، واللَّه سبحانه له الخلق والأمر، ومصدر خلقه وأمره عن حكمه لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقِضُ ومن صرف قوى ذهنه وفكره، واستنفد ساعاتِ عمره في شىءٍ مِن أحكام هذا العالم وعلمه، كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره. ويكفى الاعتبارُ بفرع واحدٍ من فروعه، وهو عبارة الرؤيا، فإن العبد إذا نفذ فيها، وكَمُل اطلاعه، جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرُنا مِن ذلك أموراً عجيبةً، يحكم فيها المعبِّرُ بأحكام متلازمة صادقة، سريعة وبطيئة، ويقول سامعها: هذه علم غيب. وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسبابٍ انفرد هو بعلمها، وخفيت على غيره، والشارع صلوات اللَّه عليه حرم من تعاطى ذلك ما مضرتُه راجحة على منفعته، أو ما لا منفعة فيه، أو ما يُخشى على صاحبه أن يجرَّه إلى الشرك، وحرم بذل المال في ذلك، وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو يخدِشُه، بخلاف علم عبارة الرؤيا، فإنه حقٌ لا باطل، لأن الرؤيا مستندة إلى الوحى المنامى، وهى جزء من أجزاء النبوة، ولهذا كُلَّما كان الرائى أصدقَ، كانت رؤياه أصدقَ، وكلما كان المعبرُ أصدق، وأبر وأعلم، كان تعبيرُه أصحَّ، بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين، فإن صناعتهم لا تَصِحُّ مِن صادق ولا بار، ولا متقيد بالشريعة، بل هم أشبهُ بالسحرة الذين كلما كان أحدُهم أكذبَ وأفجرَ، وأبعدَ عن اللَّه ورسوله ودينه، كان السحرُ معه أقوى وأشدَّ تأثيراً، بخلاف علم الشرع والحق، فإن صاحبَه كلما كان أبرَّ وأصدقَ وأدينَ، كان علمه به ونفوذه فيه أقوى، وباللَّه التوفيق.
|