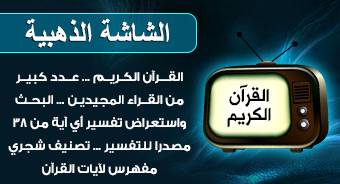|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير الثعلبي
{وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظلموا أَنْفُسَهُمْ} بالتحاكم إلى الطاغوت {جَآءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لَهُمُ الرسول لَوَجَدُواْ الله تَوَّاباً رَّحِيماً}. روى الصادق عن علي عليهما السلام قال: قدم علينا أمرؤ عندما دفنّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحثا على رأسه من ترابه وقال: يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظلموا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لَهُمُ الرسول لَوَجَدُواْ الله تَوَّاباً رَّحِيماً} فقد ظلمت نفسي فجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك. {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ} الآية. نزلت في الزبير بن العوام وخصمه، واختلف في اسمه، فقال الصالحي: ثعلبة بن الحاطب، وقال الآخرون: «حاطب بن أبي بلتعة وذلك أنهما اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الخزة كانا يستقيان به النخل فقال صلى الله عليه وسلم إسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الرجل، فقال: يا رسول الله أكان ابن عمتك؟ فتغيّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يا زبير ثم احبَسْ الماء حتى ترجع الجدد فاستوف حقك ثم أرسل إلى جارك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى الزبير بالسقي له ولخصمه فلما احفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعب الزبير حقه في صريح الحكم. ثم خرجا فمرّا على المقداد، فقال: لمن كان القضاء بالسقاية؟ فقال: قضى لابن عمته، ولوى شِدْقَه. ففطن به يهودي كان مع المقداد، فقال: قاتل الله فلولا يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه كانوا أقضى منهم، وأيمُ الله لقد أذنبنا ذنباً مرة واحدة في حياة موسى عليه السلام فدعانا موسى إلى التوبة منه، وقال: فاقتلوا أنفسكم ففعلنا مع ذلك فقتلنا سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق لو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت، فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ابن أبي بلتعة، وليِّهِ شِدْقه {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ}» الآية. وقال مجاهد والشعبي: نزلت في قصة بشر المنافق واليهودي اللذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه وقد مضت القصة. قوله: {فَلاَ} يعني ليس الأمر كما يزعمون انهم مؤمنون ثم لايرضون بحكمك ويصدون عنك ثم استأنف القسم فقال: {وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} ويجوز أن يكون لأصله كقولهم وهم ممن يحكموك أي يجعلوك حكماً {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي اختلف واختلط من أُمورهم والتبس عليهم حكمه، ومنه الشجر لا ختلاف أعضائه وقل يعطي الهودج شجار لتداخل بعضها في بعض. قال الشاعر: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً} أي ضيقاً وشكاً {مِّمَّا قَضَيْتَ} ومنه قيل للشجر الملتف الذي لا يكاد يوصل إليه حرج وحرجة وجمعها حراج. وقال الضحاك: أي إثماً يأتون بإنكارهم لما قضيت {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} أي يخضعوا وينقادوا إليك إنقياداً {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا} فرضنا وأوجبنا {عَلَيْهِمْ أَنِ اقتلوا أَنْفُسَكُمْ} ما أمرنا بني اسرائيل. {أَوِ اخرجوا مِن دِيَارِكُمْ} كما أمرناهم بالخروج من مصر {مَّا فَعَلُوهُ} أرجع الهاء إلى فعل القتل والخروج لأن الفعل وإن اختلفت أجناسه فمعناه واحد {إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} وهذه الآية نزلت في قول ثابت بن قيس وكان هو من القليل الذي استثنى الله عز وجل ورفع القليل على ضمير الفاعل بأنهم فعلوه وقلّ على التكرار تقديره: ما فعلوه، تم الكلام. ثم قال: إلاّ أنه فعله قليل منهم. كقول عمر بن معدي كرب: وقرأ أُبي بن كعب وعيسى بن عمر وابن أبي اسحاق وابن عامر {قليلاً} بالنصب، وكذا هو في مصاحف أهل الشام على النصب وقيل: فيه اضمار تقديره إلاّ أن يكون قليلاً منهم. قال الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار وابن مسعود وناس صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القليل: والله لو أمرنا لفعلنا، فالحمد لله الذي عافانا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن من أُمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي». قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً} تحقيقاً وتصديقاً لإيمانهم. {وَإِذاً لأَتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْراً عَظِيماً} ثواباً. {وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً * وَمَن يُطِعِ الله والرسول} نزلت هذه الآية في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم، وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن وقلّ لحمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ثوبان ما غيّر لونك؟»؟ فقال: يا رسول الله مابي مرض، ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك، وتوجّست وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وأني وإن ادخلت الجنة، كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فذلك حين لا أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين». وقال قتادة ومسروق بن الأجدع: أنّ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ينبغي لنا أن نفارقك فإنا لا نراك إلاّ في الدنيا فأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك، فأنزل الله تعالى {وَمَن يُطِعِ الله} في الفرائض {والرسول} في السنن {فأولئك مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النبيين والصديقين} وهم أفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم {والشهدآء} وهم الذين استشهدوا في سبيل الله {والصالحين} من صلحاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: النبيون: محمّد، والصديقون: أبو بكر الصديق، والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والصالحون سائر أصحابه. {وَحَسُنَ أولئك رَفِيقاً} يعني دوماً في الجنة كما يقول: نعم الرفقا هم. والعرب تضع الولي في معنى الجمع كثيراً، كقوله: نحن منكم قبلاً أي اطياداً، ويولون الدبر أي الأدبار ويقولون ينظرون من طرف خفي. وقوله ورفيقاً نصب على خبر {ذلك الفضل} احسان {مِنَ الله وكفى بالله عَلِيماً} يعني بالآخرة وثوابها. وقيل: بمن أطاع رسول الله وأحبه، وفي هذه الآية دلالة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذلك أن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم، وهم النبيون فجعل الروضة الأعلى للنبيين فلم يجز أن يتقدمهم فيها أحد وثنى بذكر الصديقين فلا يجوز ان يتقدمهم أحد غير النبيين ولأن يكون من النبي صديق سرهم، وقد أجمع المسلمون على تسمية أبي بكر صديقاً كما أجمعوا على تسمية محمد رسول الله ولم يجز أن يكونوا غالطين في تسميتهم محمد الرسول كذلك لايجوز أن يكونون غالطين في تسمية أبي بكر صديقاً فإذا صح انه صديق وأنه ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجز أن يتقدّمه بعده أحد والله أعلم، وفي قوله: {ذلك الفضل مِنَ الله} دليل على أنّهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل الله خلافاً، لما قالت المعتزلة ان العبد إنما ينال ذلك بفعله فلما احسن الله على عباده بما آتاهم من فضله فكان لايجوز أن يثني على نفسه بمالم يفعله، فثبت ذلك على بطلان قولهم ثم علّمهم مباشرة الحروب، فقال: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ} من عدوكم أي عدتكم وآلاتكم من السلاح {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة} [البقرة: 195] والحِذر والحَذر واحد، كالمِثل والمَثل، والعِدل والعَدل، والشِبه والشَبه، {فانفروا} أي اخرجوا {ثُبَاتٍ} أي سرايا كسرية بعد سرية وجماعة بعد جماعة، والثبات الجماعات في تفرقه واحدها ثبة {أَوِ انفروا جَمِيعاً} أي مجتمعين كلّكم مع سلم واستدل أهل القدر بهذه الآية. بقوله: {خُذُواْ حِذْرَكُمْ} قالوا: لولا أن الحذر يمنع عنهم مكايد الأعداء ما كان لأمره بالحذر إياهم معنى. فيقال لهم: الإئتمار لأمر الله والانتهاء عن نهيه واجب عليهم لأنهم به يسلمون من معصية الله عز وجل لأن المعصية تزل، فائتمروا وانتهوا عمّا نهوا عنه. وليس في هذه الآية دليل على أن حذرهم ينفع من القدر شيئاً، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إعقلها وتوكّل». والمراد به طمأنينة النفس لا أن ذلك يدفع القدر، كذلك في أخذ الحذر فهو الدليل على ذلك، أن الله تعالى أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حاكياً عنهم {لَّن يُصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا} [التوبة: 51] وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كان يصيبهم غير ما قضى عليهم ما كان هذا مني. {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ}. قال بعضهم: نزلت هذه الآية في المؤمنين لأن الله خاطبهم بقوله: {وَإِنَّ مِنْكُمْ} وقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بقوله: {مَّا هُم مِّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ} [المجادلة: 14]. وقال: أكثر أهل التفسير: إنّها نزلت في المنافقين وإنما جمع منهم في الخطاب من جهة الجنس والسبب ومن جهة الإيمان من {لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ} أي ليثاقلن ويتخلفنّ عن الجهاد والغزو. وقيل: معناه ليصدّقن غيره، وهو عبد الله بن أُبيّ المنافق وإنما دخلت اللام في من لمكان من كما تقول: إنّ فيها لأخاك فاللام في ليبطئن لام القسم وهي صلة لمن على اعتماد شبه باليمين كما يقال هذا الذي ليقومن وأرى رجلاً ليفعلن. {فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ} أي قتل وهزيمة {قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَّ} عهد {إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيداً} أي حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني مثل ما أصابهم، يقول الله {كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ} أي معرفة. وقال معقل بن حيان: معناه كأن ليس من أهل دينكم وان نظم الآية وقوله كأن لم يكن متصل بقوله: {فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ} {وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله} أي فتح وغنيمة {لَيَقُولَنَّ} هذا المنافق قول نادم حاسد: ياليتني كنت معهم في تلك الغزاة {فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً} أي آخذ نصيباً وافراً من الغنيمة. وقوله: {فأفوز} نصب على نحو التمني بالفاء، وفي التمني معنى يسرني أن افعل مافعل كأنه متشوق لذلك النصيب، كما يقول: وددت ان أقوم فمنعني أُناس ثم نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن أُحدْ.
{فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله الذين يَشْرُونَ الحياة الدنيا بالآخرة} أي انهم يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ومعنى يشرون يشترون، يقال شريت الشيء أي اشتريت، وحينئذ يكون حكم الآية: آمنوا ثم قاتلوا، لأنه لايجوز ان يكون الكافر مأموراً بشيء مقدم على الإيمان. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في المؤمنين المخلفين ومعناه (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يبتغون الحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ). ثم قال: {وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلْ} أو من يستشهد أو يعذب أو يظفر {أَجْراً عَظِيماً} في كلا الوجهين {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ} يعني الجنة ثم حضَّ المؤمنين على السعي في تخليص المستضعفين مثل {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ} أي تجاهدون {فِي سَبِيلِ الله} يعني في طاعة الله {والمستضعفين} في موضع الخفض. قال الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس ومعناه عن المستضعفين وكانوا بمكة يلقون من المشركين أذى كثيراً وكانوا يدعون ويقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها أي التي من صفتها إن أهلها ظالمون مشركون وإنّما خفض الظالم لأنه نعت الأهل فلما عاد الأهل إلى القرية كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلها كقوله: مررت بالرجل الواسعة داره، ومررت برجل حسنة عينه. {واجعل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً واجعل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيراً} يمنعنا من المشركين فأجاب الله دعاءهم. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل الله لهم النبي ولياً فاستعمل عليها عتّاب بن أُسيد. فجعله الله لهم نصيراً وكان ينصف للضعيف من الشديد فنصرهم الله به وأعانهم وكانوا أعز بها من الظلمة قبل ذلك. وفي هذه الأُية دليل على إبطال قول من زعم أنّ العبد لايستفيد بالدعاء معنى لأن الله تعالى حكى عنهم إنّهم دعوه وأجابهم وآتاهم ماسألوه ولولا أنّه أجابهم إلى دعائهم لما كان لذكر دعائهم معنى، والله اعلم. {الذين آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله} أي طاعته {والذين كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطاغوت} أي في طاعة الشيطان {فقاتلوا} أيها المؤمنين {أَوْلِيَاءَ الشيطان} أي حزبه وجنده {إِنَّ كَيْدَ الشيطان} ومكره وصنيعه ومكر من اتّبعه {كَانَ ضَعِيفاً} كما خذلهم يوم بدر. {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين قِيلَ لَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ}. قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجهني وسعد بن أبي وقاص الزهري وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة فيشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله أئذن لنا في قتال هؤلاء فإنّهم آذونا فيقول لهم: «كفّوا أيديكم عنهم فإني لم أُومَر بقتالهم». فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى بدر فلما عرفوا إنه القتال كرهه بعضهم وشق عليهم فأنزل الله تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين قِيلَ لَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ} بمكة عن القتال {وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القتال} بالمدينة أي فرض {إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ الناس} يعني مشركي مكة {كَخَشْيَةِ الله أَوْ أَشَدَّ} أي أكبر {خَشْيَةً}. وقيل: وأشد خشية كقوله آية {وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القتال} لَمِ فرضت علينا القتال {لولا أَخَّرْتَنَا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ} يعني الموت ألا تركتنا إلى أن نموت بآجالنا. واختلفوا في قوله تعالى: {إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ} فقال قوم: نزلت في المنافقين لأن قوله: {لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القتال} أي لِمَ فرضت، لايليق بالمؤمنين، وكذلك الخشية من غير الله. وقال بعضهم: بل نزلت في قوم من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم، وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان منهم الكامل الذي لايخرجه إيمانه من غلبة الطبع عليه. ومنهم من ينقص عن تلك الحالة فينفّر نفسه عمّا يؤمر به فيما يلحقه فيه الشدة. وقيل: نزلت في قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم الجهاد نافقوا عن الجهاد من الجبن، وتخلفوا عن الجهاد. ويدلّ عليه إن الله لايتعبد الكافر والمنافق بالشرائع بل يتعبدهم أولاً بالإيمان ثم بالشرائع فلما نافقوا نبّه الله على أحوالهم. وقد قال الله مخبراً عن المنافقين {بِأَنَّهُمْ آمَنُواّ ثُمَّ كَفَرُوا} [المنافقون: 3]. {قُلْ} يا محمّد لهم {مَتَاعُ الدنيا} أي منفعتها والاستمتاع بها {قَلِيلٌ والآخرة} يعني وثواب الآخرة {خَيْرٌ} أفضل {لِّمَنِ اتقى} الشرك بالله ونبوة الرسول {وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً}. قال ابن عباس وعلي بن الحكم: الفتيل الشق الذي في بطن النواة. {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ} أي ينزل بكم {الموت} نزلت في قول المنافقين لما أُصيب أهل أحد، {لَّوْ كَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ} [آل عمران: 156] فردَّ الله عليهم بقوله: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الموت وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ}. قتادة: في قصور محصنة، عكرمة: مجصّصة مشيّدة مُزيّنة، القتيبي: مطولة. الضحاك عن ابن عباس البروج: الحصون والآطام والقلاع. وفي هذه الآية ردّ على أهل القدر، وذلك أنّ الله حكى عن الكفار أنهم قالوا: {لَّوْ كَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ} [آل عمران: 156] وقال: {قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيداً} ردَّ على الفريقين بقوله: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الموت} فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلابد من زوال الروح، ومفارقتها الأجسام. فإن كان ذلك بالقتل، وإلاّ فبالموت. خلافاً لما قالت المعتزلة من أن هذا المقتول لو لم يقتله هذا القاتل لعاش، فوافق قولهم هذا الكفار، فردَّ الله عليهم جميعاً {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} الآية. نزلت في المنافقين واليهود، وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا، ومزارعنا، منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه، فأنزل الله تعالى {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} يعني اليهود والمنافقين، أي خصب وريف ورخص في السعر {يَقُولُواْ هذه مِنْ عِندِ الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ} يعني الجدب وغلاء السعر وقحط المطر {يَقُولُواْ هذه مِنْ عِندِكَ} أي من قوم محمد واصحابه. وقال بعضهم: معناه إن تصبهم حسنة يعني الظفر والغنيمة، يقولوا هذه من عند الله فإن تصبهم سيئة يعني بالقتل والهزيمة، يقولوا هذه من جندك، نزلت الذي حملتنا عليه يا محمد {كُلٌّ مِّنْ عِندِ الله} أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله. ثم عيّرهم بالجهل. فقال: {فَمَالِ هؤلاء القوم} يعني المنافقين واليهود {لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً} أي ليسوا يفقهون قولاً إلاّ التكذيب بالنعمة. قال الفراء: قوله فما لهؤلاء القوم كذبوا في الكلام، حتى توهّموا إن اللام متصلة بها، وإنهما حرف واحد، ففصلوا اللام في هؤلاء في بعض المصاحف، ووصلوها في بعضها والاتصال بالقراءة، ولا يجوز الوقوف على اللام لأنّها لام خافضة.
|