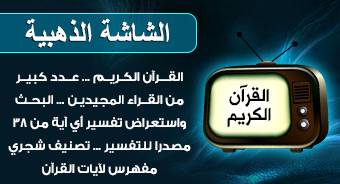.تفسير الآية رقم (61):
.تفسير الآية رقم (61):
{أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61)}يقول الحق جل جلاله:
{أمَّن جعلَ الأرضَ قراراً} أي: قارة ثابتة، ليستقر عليها الإنسان والدواب، بإظهار بعضها من الماء، ودحوها وتسويتها، حسبما يدور عليه منافعهم.
{وجعل خلالها}؛ أواسطها
{أنهاراً} جارية ينتفعون بها،
{وجعل لها رواسيَ} أي: جبالاً ثوابت، تمنعها أن تميد بأهلها، ولتتكون فيها المعادن، وينبع من حضيضها المنابع.
{وجعل بين البحرين} أي: العذب والمالح، أو: خليجي فارس والروم
{حاجزاً}؛ برزخاً مانعاً من المعارجة والمخالطة،
{أإله مع الله} في الوجود، أو: في إبداع هذه البدائع؟
{بل أكثرهم لا يعلمون} شيئاً من الأشياء، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره.الإشارة: أم من جعل أرض النفوس قراراً، لتستقر عليها أحكام العبودية، وتتصرف فيها أقدار الربوبية، وجعل خلالها أنهاراً من علوم الشرائع، وما يتعلق بعالم الحكمة من الحِكَم والأحكام، وجعل لها جبالاً من العقل لتعرف صانعها ومدبرها، وجعل بين بحر الحقيقة والشريعة حاجزاً وبرزخاً، وهو نور العقل؟ فما دام العقل صاحياً ميّز بين الحقيقة والشريعة، فيلزمه التكليف، ويعطي كل ذي حق حقه. فإذا سكر وغاب نوره سقط التكليف. وقد تُشرق على نور قمر العقل شمسُ العرفان، فتغطيه مع وجود صحوه، فيميز بين الحقائق والشرائع، وتكون عبادته أدباً وشكراً. وبالله التوفيق.
 .تفسير الآية رقم (62):
.تفسير الآية رقم (62):
{أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62)}قلت: الاضطرار: الافتعال من الضرورة، وهي الحاجة المحوجة إلى اللجأ، يقال: اضطره إلى كذا، واسم الفاعل والمفعول: مضطر، ويختلف التقدير.يقول الحق جل جلاله:
{أَمَّنْ يُجيبُ المُضْطَّر إِذا دعاه}، وهو من نزلت به شدة من شدائد الزمان، ألجأته إلى الدعاء والتضرع، كمرض، أو فقر، أو نازلة من نوازل الدهر ونوائبه، أو: المذنب إذا استغفر مبتهلاً، أو: المظلوم إذا دعا، أو: من رفع يديه ولم ير لنفسه حسنة يرجو بها القبول غير التوحيد، وهو منه على خطر، فهذه أنواع المضطر.وإجابة دعوته مقيدة بالحديث:
«الدّاعِي عَلَى ثَلاث مراتب، إما أن يُعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما يدفع عنه من السوء مثله» وأيضاً: إذا حصل الاضطرار الحقيقي حصلت الإجابة قطعاً، إما بعين المطلوب، أو بما هو أتم منه، وهو الرضا والتأييد.
{ويكشفُ السُوءَ} وهو الذي يعتري الإنسان مما يسؤوه، كضرر أو جَور،
{ويجعَلُكم خُلفاءَ الأرض} أي: خلفاء فيها، تتصرفون فيها كيف شئتم، بالسكنى وغيره، وراثة عمن كان قبلكم من الأمم، قرناً بعد قرن: أو: أو أراد بالخلافة الملك والتسلط.
{أإله مع الله} الذي يفيض على الخلق هذه النعام الجسام، يمكن أن يعطيكم مثلها؟
{قليلاً ما تذكَّرون} أي: تذكراً قليلاً، أو: زماناً قليلاً تتذكرون فيه. و
{ما}: مزيدة، لتأكيد معنى القلة، التي أريد بها العدم، أو: ما يجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوى. وتذييل الكلام بنفي عدم التذكر منهم إيذان بأن وجود التذكر مركوز في ذهن كل ذكي، وأنه من الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره. والله تعالى أعلم.الإشارة: الاضطرار الحقيقي الذي لا تتخلف الإجابة عنه في الغالب: وهو أن يكون العبد في حال شدته كالغريق في البحر وحده، لا يرى لغياثه غير سيده. وقال ذو النون: هو الذي قطع العلائق عما دون الله. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي رفع يديه إلى الله تعالى داعياً، ولم تكن له وسيلة من طاعة قدّمها. اهـ. بل يقدم إساءته بين يديه، ليكون دعاؤه بلا شيء يستحق عليه الإجابة، إلا من محض الكرم.قال القشيري: يقال للجناية: سراية، فَمَن كان في الجناية مختاراً، فليس يسلم له دعوى الاضطرار عند سراية جرمه الذي سلف، وهو في ذلك مختار، فأكثر الناس أنهم مضطرون، وذلك الاضطرار سراية ما بَرَزَ منهم في حال اختيارهم، وما دام العبد يتوهم من نفسه شيئاً من الحَوْلِ والحِيل، ويرى لنفسه شيئاً من الأسباب يعتمد عليه، ويستند إليه، فليس بمضطر، إلا أن يرى نفسه كالغريق في البحر، والضَّالِّ في المتاهة. والمضطر يرى غِيَاثه بيد سَيِّدهِ، وزِمَامَه في قبضته، كالميت في يد غاسِله، ولا يرى لنفسه استحقاقاً في أن يجاب، بل اعتقاده في نفسه أنه من أهل السخط، ولا يقرأ اسمه في ديوان السعادة، ولا ينبغي للمضطر أن يستعين بأحدٍ في أن يدعو له؛ لأن الله وَعَدَ الإجابة له؛ لا من يدعو له. اهـ.وبحث معه المحشي الفاسي في بعض ألفاظه، فانظره.قوله تعالى:
{ويكشف السُوء}: أي: ما يسوء القلب وبحجبه عن مولاه، من أكدار وأغيار، وقوله:
{ويجعلكم خلفاء الأرض} أي: تتصرفون في الوجود بأسره، بهمتكم، إن زال غم الحجاب عنكم، وشاهدتم ربكم بعين بصيرتكم وبصركم؛ لأن نور البصيرة إذا استولى على البصر، بعد فتح البصيرة، غطى نوره، فلا يرى البصر إلا ما تراه البصيرة؛ من أسرار الذات الأزلية القديمة. فمن بلغ هذا المقام كان خليفة الله في أرضه، يُملكه الوجود بأسره وما ذلك على الله بعزيز.
 .تفسير الآية رقم (63):
.تفسير الآية رقم (63):
{أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)}يقول الحق جل جلاله:
{أمَّن يهديكم في ظلمات البَرِّ والبحر} ليلاً، وبعلامات في الأرض نهاراً؟ أو: أمّن يهديكم إلى سلوك الطريق التي تُوصلكم إلى مقصدكم، وأنتم في ظلمات الليل، سواء كنتم في البر أو البحر؟ فلا هادي إلى ذلك إلا الله تعالى.
{ومن يُرسل الرياح}، أو بالإفراد.
{نُشراً} بالنون- أي: تنشر السحاب إلى الموضع الذي أمر الله بإنزال المطر فيه، أو
{بُشرا}- بالباء- أي مبشرة بالمطر
{بين يدي رحمته}؛ قدَّام المطر علامة عليه،
{أإله مع الله} يفعل ذلك؟
{تعالى الله عما يُشركون}. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار للإشعار بعلِّية الحُكم، أي: تعالى الله وتنزّه بذاته المنفردة بالألوهية، المقتضية لكون كل المخلوقات مقهوراً تحت قدرته، عن وجود ما يشركونه به تعالى.الإشارة: أمّن يهديكم إلى حل ما أشكل عليكم، وأظلمت منه قلوبكم، من علم بَر الشرائع. وبحر الحقائق، فيهديكم في الأول إلى كشف الحق والصواب وفي الثاني إلى كشف الغطاء ورفع الحجاب، أو: في الأول إلى علم البيان، وفي الثاني إلى عين العيان بالذوق والوجدان. أو: في الأول إلى علم اليقين، وفي الثاني إلى عين اليقين وحق اليقين. ومَن يُرسل رياح الواردات الإلهية، بشارة بين يدي رحمته بالوصول إلى حضرته، وهو التوحيد الخاص. ولذلك ختمه بقوله:
{تعالى الله عما يُشركون} من رؤية وجود السِّوى.
 .تفسير الآيات (64- 65):
.تفسير الآيات (64- 65):
{أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)}قلت:
{من}: إما فاعل بيعلم، و
{الغيب}: بدل منه، و
{الله}: مفعول، و
{إلا الله}: بدل على لغة تميم، أي: إبدال المنقطع، وإما مفعول بيعلم، و
{الغيب} بدل منه و
{الله}: فاعل، والاستثناء: مفرغ.يقول الحق جل جلاله:
{أمّن يبدأُ الخلقَ} أي: ينشئ الخلق
{ثم يُعيده} بعد الموت بالبعث. وإنما قيل لهم:
{ثم يُعيده} وهم منكرون للإعادة؛ لأنهم أزيحتْ شبهتهم بالتمكن من المعرفة، والإقرار، فلم يبقَ لهم عذرٌ في الإنكار.
{ومن يرزقكم من السماء} بالمطر
{والأرض} أي: ومن الأرض بالنبات، أي: يرزقكم بأسباب سماوية وأرضية، قد رتبها على ترتيب بديع، تقضيه الحكمة التي عليها بني أمر التكوين،
{أإله مع الله} يفعل ذلك؟
{قل هاتُوا بُرهانَكم} أي: حجتكم، عقلية أو نقلية، على إشراككم،
{إن كنتم صادقين} في دعواكم أن مع الله إلهاً آخر.
{قل لا يعلم مَنْ في السماوات والأرضِ الغيبَ إلا الله}، بعد ما حقق سبحانه انفراده بالألوهية، ببيان اختصاصه بالقدرة الكاملة والرحمة الشاملة عقَّب بذكر ما هو من لوازمه وهو اختصاصه بعلم الغيب، تكميلاً لما قبله، وتمهيداً لما بعده من أمر البعث. قالت عائشة- رضي الله عنها-: (منْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَدْ أعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيةَ، والله تعالى يقول:
{قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيبَ إلا الله}).دخل على الحجاج مُنجِّم فأخذ الحجاج حصياتٍ، قد عدَّها فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب، فأصاب، ثم اغتفله الحجاجُ، فأخذ حصيات لم يعدها، فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب، فأخطأ، فقال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها في يدك، فقال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذلك أحصيتَه فخرج من حَد الغيب فحسبتُ فأصبتُ وإن هذا لم تعرف عدته، فصار غيباً، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى.ومن جملة الغيب: قيام الساعة، ولذلك قال:
{وما يشعرون أيّان يُبعثون} أي: متى ينتشرون من القبور، مع كونه مما لابد لهم منه، ومن أهل الأمور عندهم. والله تعالى أعلم.الإشارة: الرزق ثلاثة: رزق الأشباح، ورزق القلوب، ورزق الأرواح، فرزق الأشباح معلوم، ورزق القلوب: اليقين والطمأنينة، ورزق الأرواح: المشاهدة والمكالمة. قُل من يرزق قلوبكم وأرواحكم من سماء غيب القدرة وأرض الحكمة؟ فلا رازق سواه، ولا برهان على وجود ما سواه، ولا يعلم الغيب إلا الله. أو: من كان وجوده بالله قد غاب في نور الله، فَشَهِدَ الغيب بالله. والله تعالى أعلم.
 .تفسير الآيات (66- 68):
.تفسير الآيات (66- 68):
{بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآَبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68)}قلت: قرأ الجمهور:
{ادّارَكَ} بالمد، وأصله: تدارك، فأدغمت التاء في الدال، ودخلت همزة وصل. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر:
{ادّرك}، وأصله: افتعل، بمعنى تفاعل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو:
{أدرك} أفعل.يقول الحق جل جلاله:
{بل ادّارك} أي: تدارك وتناهى وتتابع أسباب
{عِلْمُهم في الآخرة} أي: بالآخرة، أو: في شأنها، بما ذكرنا لهم من البراهين القطعية، والحجج العقلية، على كمال قدرتنا. ومع ذلك لم يحصل لهم بها يقين،
{بل هم في شكٍّ منها}، والمعنى: أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة لا ريب فيها قد حصلت لهم ومكّنوا من معرفته بما تتابع لهم من الدلائل. زمع ذلك لم يحصل لهم شيء من علمها، بل شكّوا. أو: أدرك علمهم، بمعنى: يدركهم في الآخرة حين يرون الأمر عياناً، ولا ينفعهم ذلك. قاله ابن عباس وغيره.
{بل هم} اليوم
{في شكٍّ منها بل هم منها عَمُونَ} لا يُبصرون دلائلها، ولا يلتفتون إلى العمل لها. والإضرابات الثلاثة تنزيل لأحوالهم، وتأكيد لجهلهم. وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة مع تتابع أسباب علمها، ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية، ثم بما هو اسوأ حالاً، وهو العمى، وجعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه، فلذا عداه ب من دون عن؛ لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي منعهم عن التفكر والتدبر.ووجه اتصال مضمون هذه الآية- وهو وصف المشركين- بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكن من المعرفة بما قبله، وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب، وأن العباد لا علم لهم بشيء بذلك: هو أنه لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب، وكان هذا بياناً لعجزهم، ووصفاً لقصور علمهم، وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه، وهو أنهم يقولون للكائن الذي لابد من كونه- وهو وقت بعثهم، ومجازاتهم على أعمالهم: لا يكون، مع أن عندهم أسباب معرفة كونه، لا محالة. اهـ. قاله النسفي.
{وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرَجُونَ} أي: أنُخرج من القبور أحياء إذا صرنا تراباً وآباؤنا. وتكرير الاستفهام في
{أئذا} و
{أَئِنا} في قراءة عاصم، وحمزة؛ وخلف، إنكار بعد إنكار، وجحود بعد جحود، ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه. والعامل في (إذا): مادلّ عليه
{لمخرجون} وهو: نُخرج، لا مخرجون، لموانع كثيرة. والضمير في
{أئنا} لهم ولآبائهم.
{لقد وُعِدْنَا هذا} البعث
{نحن وآباؤنا من قبلُ}؛ من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قدّم هنا
{هذا} على
{نحن} وفي المؤمنون قدّم
{نحن}؛ ليدل هنا أن المقصود بالذكر هو البعث وثمَّ المبعوث؛ لأن هنا تكررت أدلة البعث قبل هذا القول كثيراً، فاعتنى به بخلاف ثم.ثم قالوا:
{إنْ هذا إلا أساطيرُ الأولينَ}: ما هذا إلا أحاديثهم وأكاذيبهم. وقد كذبوا، ورب الكعبة.الإشارة: العلم بالآخرة يَقْوى بقوة العلم بالله، فكلما قوي اليقين في جانب الله قوي اليقين في جانب ما وعد الله به؛ من الأمور الغيبية، فأهل العلم بالله الحقيقي أمور الآخرة عندهم نُصب أعينهم، واقعة في نظرهم؛ لقوة يقينهم. وانظر إلى قول حارثة رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
«ما حقيقة إيمانك؟» فقال: يا رسول الله؛ عزَفَتُ الدنيا من قلبي، فاستوى عندي وذهبا ومدرها. ثم قال: وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأهل النار يتعاوون فيها، فقال له صلى الله عليه وسلم:
«قد عرفت فالزمْ، عبدٌ نوّر الله قلبَه» اللهم نَوِّر قلوبنا بأنوار معرفتك الكاملة، حتى نلقاك على عين اليقين وحق اليقين. آمين.
 .تفسير الآيات (69- 73):
.تفسير الآيات (69- 73):
{قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73)}يقول الحق جل جلاله:
{قُلْ} لهم:
{سيروا في الأرض فانظر كيف كانت عاقبةُ المجرمين} بسبب تكذيبهم للرسل- عليهم السلام- فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله- عز وجل- وحده، واليوم الآخر، الذي ينكرونه، فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه كفاية لأولي البصائر. وفي التعبير عن المكذبين بالمجرمين، لطف بالمسلمين، بترك الجرائم، وحث لهم على الفرار منها، كقوله:
{فَدَمْدمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ} [الشمس: 14] و
{مِّمَّا خطيائاتهم أُغْرِقُواْ} [نوح: 25].ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:
{ولا تحزنْ عليهم} أي: لأجل أنهم لم يتبعوك، ولم يُسْلِموا فَيَسْلَمُوا.
{ولا تكن في ضَيْقٍ}؛ في حرج صدر
{مما يمكرون}؛ من مكرهم وكيدهم، أي: فإن الله يعصمك من الناس. يقال: ضاق ضيقاً- بالفتح والكسر.
{ويقولون متى هذا الوعدُ} أي: وعد العذاب التي تعدنا، إن كنت من الصادقين في إخبارك بإتيانه على من كذّب. والجملة باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار بذلك.
{قل عسى أن يكون رَدِفَ لكم بعضُ الذي تستعجلون} أي: تبعكم ولحقكم. استعجلوا العذاب، فقيل لهم: عسى أن يكون رَدِفَ، أي: قرب لكم بعضه. وهو عذاب يوم بدر، واللام زائدة للتأكيد. أو: ضمّن الفعل معنى يتعدّى باللام، نحو: دنا لكم، أو: أزف لكم. وعسى ولعل وسوف، في وعد الملوك ووعيدهم، يدل على صدق الأمر، وجدّه، وعلى ذلك جرى وعد الله، ووعيده.
{وإن ربك لذُو فضلٍ على الناس} أي: إفضال وإنعام على كافة الناس. ومن جملة إنعامه: تأخير العقوبة عن هؤلاء، بعد استعجالهم لها،
{ولكنَّ أكثرهم لا يشكرون} أي: أكثرهم لا يعرفون حق النعمة، ولا يشكرونها، فيستعجلون بجهلهم وقوع العذاب، كدأب هؤلاء. والله تعالى أعلم.الإشارة: التفكر والاعتبار من أفضل عبادة الأبرار، ساعة منه أفضل من عبادة سبعين سنة. ومن أجلّ ما يتفكر فيه الإنسان: ما جرى على أهل الغفلة والبطالة والعصيان، من تجرع كأس الحِمام، قبل النزوع والإقلاع عن الإجرام، فندموا حيث لم ينفع الندم، وقد زلَّت بهم القدم، فلا ما كانوا أمَّلوا أدركوا، ولا إلى ما فاتهم من الأعمال الصالحات رجعوا. فليعتبر الإنسان بحالتهم، لئلا يجري عليه ما جرى عليهم، وليبادر بالتوبة إلى ربه، وليشهد يده على أوقات عمره، قبل أن تنقضي في البطالة والتقصير، فيمضي عمره سبهللاً. ولله در القائل:
السِّبَاق السِّبَاقَ قَوْلاً وَفِعْلاً ** حَذِّرِ النَّفْسَ حَسْرةً المسْبُوقِقال أبو على الدقاق رضي الله عنه: رؤي بعضهم مجتهداً، فقيل له في ذلك، فقال: ومن أولى مني بالجهد، وأنا أطمع أن ألحق الأبرار الكبار من السلف. اهـ. ويقال للواعظ أو للعارف، إذا رأى إدبار الناس عن الله، وإقبالهم على الهوى:
{ولا تحزن عليهم..} الآية.