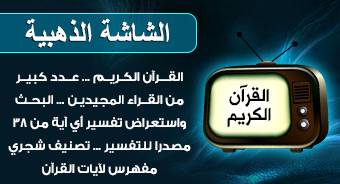وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة. فإنه أولًا استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم اللباس، بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه، فصار اسم اللباس مستعارًا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم، ثم استعار اسم الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف، المعبر عنه باللباس، بجامع التعرف والاختبار في كل من الذوق بالفم، ووجود الألم من الجوع والخوف. وعليه ففي اللباس استعارة أصلية كما ذكرنا. وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع، والخوف استعارة تبعية.
وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم، مع أن التحقيق الذي لا شك فيه: أن كل ذلك لا فائدة فيه، ولا طائل تحته، وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق وعلى غيره من وجود الألم واللذة، وأنها تطلق اللباس على المعروف، وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللباس من الاشتمال. كقوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}، وقول الأعشى: إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا
وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس، فلا مانع من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر باسم اللباس. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ}. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما أحل الله من رزقه، مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من تحريم ما أحل الله.
وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة. كقوله: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ}، وقوله: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ}، وقوله: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ}، وقوله: {وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا}، وقوله: {وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ}. وقوله {حِجْرٌ} أي حرام، إلى غير ذلك من الآيات، كما تقدم.
وفي قوله {الكذب} أوجه من الإعراب: أحدهما ـ أنه منصوب بـ {تَقُولُواْ} أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة.
كما ذكر في الآيات المذكورة آنفًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل. واللام مثلها في قولك: لا تقولوا لما أحل الله: هو حرام. وكقوله: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ}. وجملة {هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ} بدل من {الْكَذِبَ} وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب. {تَصِفُ} بتضمينها معنى تقول. أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم، فتقول هذا حلال وهذا حرام. وقيل: {الْكَذِبَ} مفعول به لـ {تَصِفُ}. و{مَا} مصدرية، وجملة {هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} متعلقة بـ {لاَ تَقُولُواْ} أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لو صف ألسنتكم الكذب. أي لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم، ويجول في أفواهكم. لا لأجل حجة وبينة ـ قاله صاحب الكشاف. وقيل: {الْكَذِبَ} بدل من هاء المفعول المحذوفة. أي لما تصفه ألسنتكم الكذب.
تنبيه
كان السّلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام. خوفًا من هذه الآيات.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال الدارمي أبو محمد في مسنده: أخبرنا هارون، عن حفص، عن الأعمش قال: "ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون".
وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. انتهى.
وقال الزمخشري: واللام في قوله {لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ} من التعليل الذي لا يتضمن معنى الفرض اهـ. وكثير من العلماء يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقصد به علة غائية. كقوله: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً}، وقوله هنا: {لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ} أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف.
قال مقيده عفا الله عنه: بل كل ذلك من أساليب اللغة العربية. فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائية. كقوله: {وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}. ومن أساليبها الإتيان باللاّم للدلالة على ترتب أمر على أمر. كترتب المعلول على علته الغائية. وهذا الأخير كقوله: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً}. لأن العلة الغائية الباعثة لهم على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوًا، بل ليكون لهم قرة عين. كما قالت امرأة فرعون: {قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} ولكن لما كان كونه عدوًا لهم وحزنًا يترتب على التقاطهم له. كترتب المعلول على علته الغائية ـ عبر فيه باللام الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربي، فلا حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث.
{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ}
قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إن الذين يفترون عليه الكذب ـ أي يختلقونه عليه ـ كدعواهم أنه حرم هذا وهو لم يحرمه. ودعواهم له الشركاء والأولاد ـ لا يفلحون. لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعًا قليلًا لا أهمية له، وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم، الشديد المؤلم.
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله في يونس: {قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ}، وقوله: {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ}، وقوله: {فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}، إلى غير ذلك من الآيات.
وقوله {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} خبر مبتدإ محذوف. أي متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله {لاَ يُفْلِحُونَ} أي لا ينالون الفلاح، وهو يطلق على معنيين: أحدهما ـ الفوز بالمطلوب الأكبر. والثاني ـ البقاء السرمدي. كما تقدم بشواهده. قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}.
هذا المحرم عليهم، المقصوص عليه من قبل المحال عليه هنا هو المذكور في (سورة الأنعام) في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}.
وجملة المحرمات عليهم في هذه الآية الكريمة ظاهرة، وهو كل ذي ظفر: كالنعامة والبعير، والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو الثروب) وشحم الكلى. أما الشّحم الذي على الظهر، والذي في الحوايا وهي الأمعاء، والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من الشحوم المختلطة بالعظام ـ فهو حلال لهم. كما هو واضح من الآية الكريمة. قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}. أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصَّلاة والسلام: بأنه أمة. أي إمام مقتدى به، يعلم الناس الخير. كما قال تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً}، وأنه قانت لله، أي مطيع له. وأنه لم يكن من المشركين، وأنه شاكر لأنعم الله، وأن الله اجتباه، أي اختاره واصطفاه. وأنه هداه إلى صراط مستقيم.
وكرر هذا الثناء عليه في مواضع أخر، كقوله: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى}، وقوله: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، وقوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ}، وقوله: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}، وقوله عنه: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، وقوله: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، وقوله: {وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه.
وقد قدمنا معاني "الأمة" في القرآن. قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً}. قال بعض العلماء: الحسنة التي آتاه الله في الدنيا: الذرية الطيبة، والثناء الحسن. ويستأنس لهذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب إخلاصه لله، واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناءً حسنًا باقيًا في الدنيا. قال تعالى: {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا نَبِيّاً وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً}، وقال: {وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ}، وقال: {وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ}. قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} .
ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبيِّنا صلى الله عليه وسلم الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين.
وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} إلى قوله {الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}، وقوله: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ}، إلى غير ذلك من الآيات. والملة: الشريعة. والحنيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من الحنف: وهو اعوجاج الرجلين. يقال: برجله حنف أي اعوجاج. ومنه قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله
وقوله {حَنِيفًا} حال من المضاف إليه. على حد قول ابن مالك في الخلاصة: ما كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا
لأن المضاف هنا وهو {مِلَّةَ} كالجزء من المضاف إليه وهو {إبراهيم} لأنه لو حذف لبقي المعنى تامًا. لأن قولنا: أن اتبع إبراهيم، كلام تامُّ المعنى كما هو ظاهر، وهذا هو مراده
بكونه مثل جزئه. قوله تعالى: {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} . أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة: من إيضاح الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قال: أعرض عن أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: {فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}. ومن ذلك القول اللين: قول موسى له {هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى}. قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن سبيله. أي زاغ عن طريق الصواب والحق، إلى طريق الكفر والضلال.
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله (في أول القلم) {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ}، وقوله (في الأنعام): {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}، وقوله (في النجم): {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى} والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا.
والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي {أَعْلَمُ} في هذه الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل. لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة. فهي كقول الشنفرى: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
أي لم أكن بعجلهم. وقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتًا دعائمه أعز وأطول
أي عزيزة طويلة. قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} . نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة، في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحد. فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم. فنزلت الآية الكريمة، فصبروا لقوله تعالى: {لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} مع أن سورة النحل مكية، إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن. كقوله: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}، وقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}، وقوله: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ} إلى قوله {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}، وقوله {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً} إلى قوله {أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً} كما قدمنا.
 مسائل بهذه الآية الكريمة
مسائل بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى ـ يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر، وهي أنك إن ظلمك إنسان: بأن أخذ شيئًا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته، وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة. فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟
أصح القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة. لقوله تعالى في هذه الآية: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} الآية، وقوله: {فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.
وممن قال بهذا القول: ابن سيرين وإبراهيم النخعي، وسفيان ومجاهد، وغيرهم.
وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك. وعليه درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها.
واحتج من قال بهذا القول بحديث "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك" اهـ. وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به. لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه.
المسألة الثانية ـ أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به. ويؤيده "رضه صلى الله عليه وسلم رأس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية فعل بها مثل ذلك".
وهذا قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه، زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد، لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص. وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء.
المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على الجناية الأولى في قوله: {بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} والجناية الأولى ليست عقوبة. لأن القرآن بلسان عربي مبين. ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ. فيؤدي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام. كقول الشاعر: قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبةً وقميصا
أي خيطوا لي. وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير: هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذَّكر
بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإناث.
ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ الآخر ـ قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ}، ونحوه أيضًا.
قوله: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} مع أن القصاص ليس بسيئة وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}. لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس باعتداء كما هو ظاهر، وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين: قوله تعالى: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}.
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر، وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه. لقوله: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ} وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}، لأن قوله: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ}، معناه أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، بفضل الله عليه، وتيسر ذلك له. قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين المحسنين. وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان.
وهذه المعية بعباده المؤمنين، وهي بالإعانة والنَّصر والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}، وقوله: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ}، وقوله: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} وقوله: {قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}، إلى غير ذلك من الآيات.
وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم، ونفوذ القدرة، وكون الجميع في قبضته جل وعلا: فالكائنات في يده جل وعلا أصغر من حبّة خردل، وهذه هي المذكورة أيضًا في آيات كثيرة. كقوله: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، وقوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ}، وقوله: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ}، وقوله: {وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ}، إلى غير ذلك من الآيات.
فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال، على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، وهو محيط بخلقه، كلهم في قبضة يده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
تم بحمد الله تفسير سورة النحل ولله الحمد.